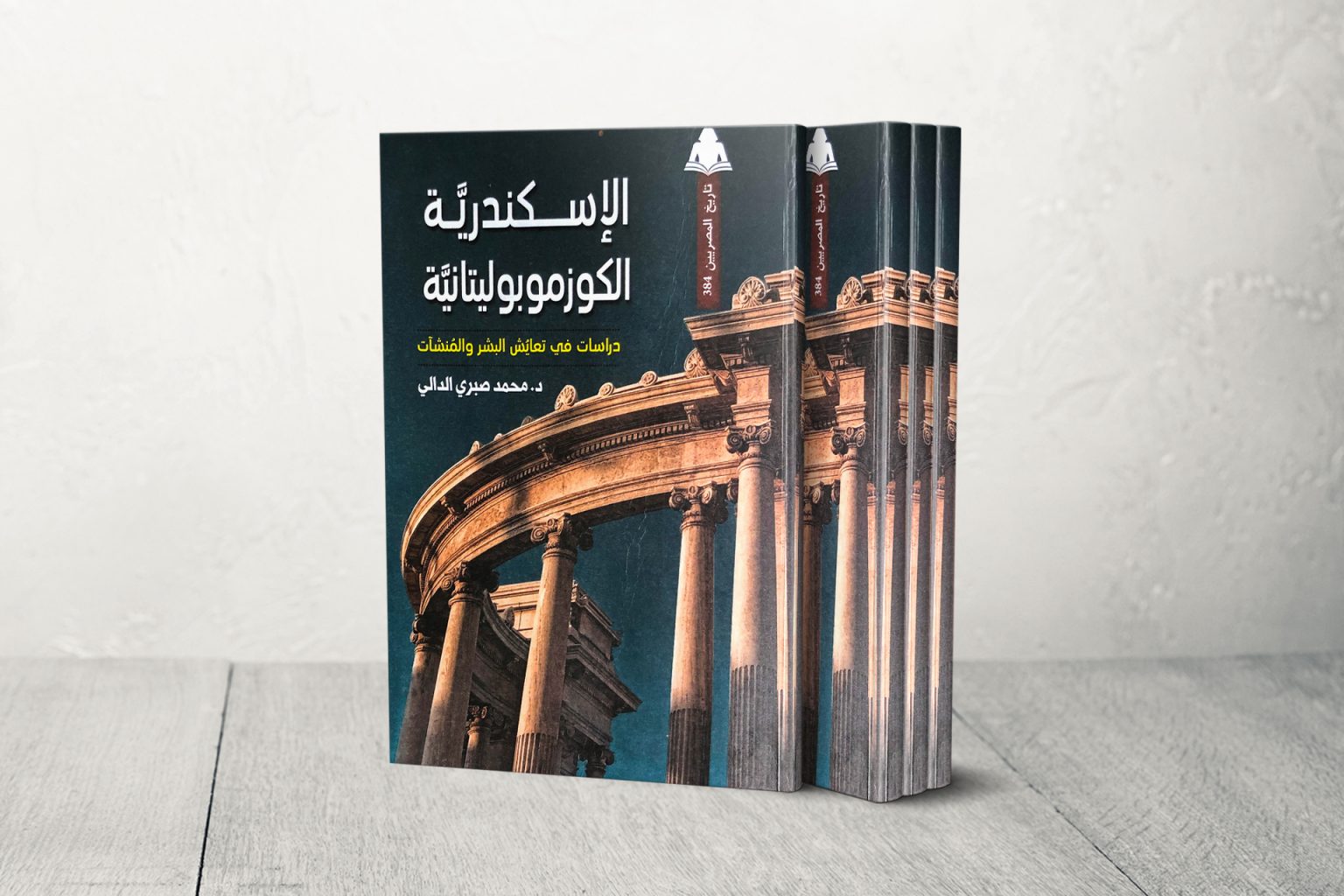“الإسكندرية الكوزموبوليتانية، دراسات في تعايش البشر والمنشآت”، كتاب جديد موضوعه مدينة ذات تنوع بشري فريد، من خلال قضايا ودراسات أربع، تضع المدينة الكوزموبوليتانية (المتنوعة) في مواجهة الحداثة الغربية.
ويتناول الكتاب الصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب من تأليف دكتور محمد صبري الدالي، في دراسته الأولى بعنوان “قبل الاستعمار والحداثة الغربية، الأوربيون في الإسكندرية بين التعايش المشترك والاختلاف”، محددا فترة الدراسة من أوائل القرن الـ16 وحتى أواخر القرن الـ18، متخذا الإسكندرية دراسة حالة بالاعتماد على الوثائق، بالإضافة إلى كتابات المؤرخين المصريين وبعض قصص الرحالة.
والدراسة لا تظهر الإسكندرية في العصر العثماني مثالا على التعايش عن طريق انتقاء “اللقطات” الإيجابية، بل تحاول رصد حقيقة الأوضاع التي عاشتها آنذاك، وبالاعتماد على ما أوردته الوثائق والمصادر، من خلال طرحها لسؤال رئيس: إلى أي مدى تعايش أهالي الإسكندرية والأوربيون، ومن ثم إلى أي مدى كانت المدينة “كوزموبوليتانية” حقا في تكوينها السكاني؟
ويؤكد كتاب، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان، أنه لا بد من التفرقة بين التعايش، والخلافات والنزاعات، حيث إنه طالما وجدت مصالح خاصة ومعاملات وجدت النزاعات التي تعكس نوعا من ضرورات التعايش.
ولمدينة الإسكندرية تاريخ طويل من التعاون والعداء مع الأوروبيين، وكانت مدينة معروفة جيدا للأوروبيين، وكانت من المدن القليلة التي زارها السلطان سليم الأول، ومن مينائها خرج وعاد معظم المصريين الذين رحلوا إلى إسطنبول.
وتعد أصول السكان من أهم دلالات “كوزموبوليتانية” الإسكندرية، إذ كان يوجد بها بجانب المصريين، أجانب من أصول عربية وتركية وأوروبية، مثل يهود إسبانيا وفرنسا، واختلط مع هؤلاء الكثير من التجار والسياح والبحارة وغيرهم من فرنسيين وألمان وإسبان ومجريين وهولنديين وبلجيك (فلمنك) وبرتغاليين وروس ونمساويين، بالاضافة لليونانيين والألبان والكريتيين والقبارصة، وكثير منهم فضلوا البقاء فيها، فاشتروا البيوت والمحلات والمراكب، وتزوجوا من بني جلدتهم، ومن غيرهم، وكونوا العائلات.
وعلى إثر هذا التنوع الإثني كانت الإسكندرية عامرة باللغات واللهجات، ما أدى إلى أن تكون هناك أنماط عديدة للحياة، وبقدر الإثنيات تعددت الديانات والمذاهب في الإسكندرية، فبالإضافة للمسلمين والأقباط واليهود الربانيين، كان هناك الروم (الملكانيون) الكاثوليك والبروتستانت وبعض اليهود الأشكناز.
الوثائق العدلية
واعتمد المؤلف على وثائق محكمة الإسكندرية في معرفة نسبة وجود الأوروبيين في المدينة، في النصف الأول من القرن الـ16 الميلادي، حيث تراوحت نسبة تردد الأوروبيين على المحكمة ما بين 8.52% و26.1% حتى ما بعد الاحتلال الفرنسي لمصر 1798.
ويدلل النشاط التجاري للمدينة على تعزيز إمكانية التعايش، حيث تميزت الإسكندرية بوجود طوائف قوية، مثل “طائفة مغربلي البهار” و”طائفة تجار الجلود”، كما تميزت المدينة بوجود وكالات تجارية ضخمة، بالقياس إلى حجمها وتعداد سكانها، تبادل فيها سكندريون وأوروبيون العمل بالتجارة، وبقدر ما ارتبطت أنشطتهم بالبحر والقادمين منه والمسافرين فيه، بقدر ما أتاحت للسكندريين الفرصة والقدرة والتعامل مع الآخرين، أيا كانت جنسياتهم ودياناتهم ومذاهبهم.
لقد عاش الأوروبيون في الإسكندرية حياة طبيعية إلى حد كبير، كما يقول المؤلف، وكانت لديهم القدرة على الزواج، واشتغلت سيداتهم بالتجارة، وارتدوا الملابس القصيرة والضيقة ومارسوا هواياتهم على مرأى من الأهالي.
وينهي المؤلف أولى دراسات الكتاب بالقول إنه إذا كان بإمكاننا أن نفهم التعاملات على اعتبارها تعكس أشكالا من التعايش، فمن الإنصاف فهم النزاعات في هذا الإطار أيضا.
القرصنة المتوسطية
وعلى الرغم من أن الإسكندرية جذبت إليها أبناء العالم من المتصوفة الأخيار، فقد جذبت إليها كذلك القراصنة في ذلك العصر، وفي الدراسة الثانية يناقش الكاتب القرصنة وقضاياها في البحر المتوسط، وشبكات تحرير الأسرى في الإسكندرية خلال العصر العثماني.
والقرصنة نوعان، قرصنة الدولة، وقرصنة الأفراد، وكانت هناك العديد من قوى ومراكز القرصنة الأوروبية في مياه البحر المتوسط، فهناك إسبانيا التي مارست القرصنة لفترة طويلة ضد المسلمين، وكانت جزيرة مالطا أخطر مراكز القرصنة الأوروبية ونشط قراصنتها ضد التجارة الإسلامية بعد أن طردهم العثمانيون من جزيرة رودس.
وفي المقابل، كانت هناك مراكز للقرصنة في جنوب البحر المتوسط، مثل مدن الجزائر ووهران وجربة، ساعد على وجودها هجرة العديد من الأندلسيين “الموريسكيين” بعد سقوط غرناطة 1492م، وانضمام أعداد كبيرة منهم إلى صفوف القراصنة في جنوب البحر المتوسط، وقاموا بعمليات إغارة على شبه الجزيرة الإيبيرية لتخليص إخوانهم ونقلهم من هناك.
ومنذ أن انتزع قائد القوات البحرية العثمانية بالجزائر خير الدين بربروس تونس من أيدي الإسبان سنة 1534، ومدت الجزائر سيطرتها على البحر المتوسط بعد الحملة الإسبانية الفاشلة على الجزائر سنة 1541، ترسخت شهرة الجزائر بوصفها قوة لا تقهر وحصنا منيعا، وبعد طرد فرسان مالطا من طرابلس عام 1551، والاستيلاء على جزيرة جربة 1560 تحولت الجزيرة التونسية لمركز رئيسي للقراصنة المسلمين جنوب المتوسط.
نبلاء وقراصنة
وعن أعداد الأسرى ضحايا الحرب والقرصنة ذكر البعض أن عدد الأسرى الأوروبيين في مدينة الجزائر سنة 1767 كان 7 آلاف بما يمثل 20% من تعداد المدينة البالغ 50 ألفا، وذكر آخرون أن عدد الأسرى المسيحيين في تونس أواخر القرن الثامن عشر كان 1500، وأن عدد أرقاء سلطان المغرب مولاي إسماعيل كان 25 ألفا، أما في الجانب الأوروبي فذكر أن 2% من سكان صقلية كانوا أسرى مسلمين، وأن عدد الأرقاء المسلمين لدى أوروبا سنة 1785 كان 48 ألفا وزيادة.
أما أسواق بيع الأسرى في حوض البحر المتوسط فكانت كثيرة، ومنها “سوق ليفورنو/ القورنة” (بإقليم توسكانا شمال غرب إيطاليا، وعاصمتها فلورنسا)، والذي تحول في القرنين الـ16 والـ17 إلى سوق مهمة تضاهي في أهميتها سوق البندقية ومالطا.
في المقابل، وفي القرن الثامن عشر، تصف الوثائق الجماعات الكثيرة من مختلف أنحاء أوروبا التي مرت بأسواق النخاسة في مدن سلا وأسفي وطنجة وتونس والجزائر، وهذه الجماعات من الرجال والنساء والأطفال، كانت ضحايا لعمليات اختطاف من السواحل الأوروبية الجنوبية، حيث اشتهر الإنجليز بخطف الركاب وبيعهم في الجزائر وطنجة وسلا.
ويشير المؤلف إلى أن الإسكندرية في العصر العثماني كانت بمثابة مركز للتجارة وتحرير الأسرى، ولم تكن مركزا للقرصنة، وهذا ما أكده الحسن الوزان المعروف باسم ليون الأفريقي (1494 – 1554) في كتابه” وصف إفريقيا”، ولم يشارك أهل الإسكندرية في أعمال القرصنة لرغبتهم القوية في التعايش مع الآخر.
وإن لم يستطع المؤلف تقديم أعداد دقيقة للأسرى، فكل القرائن كانت تشير على ضخامة أعدادهم، ويعتقد بعض الرحالة أن الفترة الممتدة بين 1500 – 1800 شهدت وجود ما بين 80 – 120 ألف أسير مسلم بالدويلات الإيطالية وحدها، على أن هناك بعض الباحثين الإيطاليين يشيرون بأنه تم أسر ما لا يقل عن نصف مليون أفريقي مسلم أخذوا عبيدا إلى إيطاليا خلال القرنين الـ16 والـ17.
ونتيجة لانتشار ظاهرة الأسر، وكثرة الهجامين من القراصنة في المتوسط ظهرت “شبكات تحرير الأسرى” وكان أعضاء هذه الشبكات من الشرق والغرب يعقدون صفقات لتحرير الأسرى في مقابل “عمولات” كان يتم دفعها للقراصنة، وفي كثير من الأحيان كان القائم بتحرير الأسرى يقوم بدفع الفدية من ماله باعتباره “قرضا شرعيا” حتى عودة الأسير ويستوفي ماله في مقابل فوائد ربوية، بحسب الكتاب.
سيرة العِطاش في الإسكندرية
وجاءت الدراسة الثالثة بعنوان “منشآت سبل المياه في الإسكندرية، من القرن الـ16 وحتى أوائل القرن الـ19″، حيث يشير المؤلف إلى أن تسبيل المياه في المدن المصرية حظي بقدر كبير من الأهمية، لكن تلك الأهمية زادت بالنسبة إلى الإسكندرية حيث لا مصادر طبيعية لها من المياه لوقوعها بين البحر والصحراء، إلى أن تم حفر ترعة المحمودية في عهد محمد علي.
ولهذا لاقت قضية وصول المياه إلى الإسكندرية اهتماما كبيرا في الوثائق وفي كتابات الرحالة والمؤرخين في تلك الحقبة وما بعدها مثل “الوزان” و”نيبور” و”بتس” و”الزياني”.
واعتمد توفير المياه في الإسكندرية على الأوقاف والمبادرات الفردية، ولهذا كان وجود ترعة المحمودية منذ عشرينيات القرن التاسع عشر الميلادي، متغيرا جديدا أسهم في تغيير مصادر وكيفية إمداد المدينة بالمياه ووسائل وآليات توزيعها.
والسؤال: كيف استطاعت المدينة التغلب على هذه المشكلة؟ وإذا كان دور المجتمع الأهلي والمبادرات الفردية أصبح الآن أحد معالم “الحداثة” ومن مظاهر الاستجابة الإيجابية للفرد في مجتمعه، فإلى أي مدى قام المجتمع السكندري الحضري بدوره، وإلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك من معالم “الحداثة” في الإسكندرية قبل الاحتلال الفرنسي وتأثيرات الغرب؟
أوردت الوثائق أكثر من 115 منشأة لتسبيل المياه من أجل شرب البشر والحيوانات في الإسكندرية مثل “الأسبلة، والمزملات، والبزابيز، والمزيرات، والملايات، والأحواض” وكانت كل منشأة منها لتسبيل المياه، إما مستقلة، أو ملحقة بصهاريج بيوت أو بمساجد أو تكايا أو وكالات أو حوانيت، أو حتى ملحقة بأضرحة ومدافن”.
وكانت أوجه الخير هي السبب المباشر والأهم لتسبيل مياه الشرب، وكان تسبيل المياه مرتبطا بانتفاع المسلمين إذا ما كان ملحقا بمنشآت دينية، ولكنه كان أيضا متاحا للجميع دون تحديد دين، ومن ثم كانت الصيغ في الوثائق تشير إلى أن الماء “مسبل لشرب الآدميين” أو “لسقي العِطاش، أو مسبل على المساكين والفقراء بالثغر لشرب العطاش”.
قنوات الباشا
وينتهي الكتاب بالدراسة الرابعة والأخيرة “ترعة المحمودية ودورها في نقل الغلال إلى الإسكندرية في عهد محمد علي” والدراسة بالرغم من بعدها عن موضوع “الحداثة الغربية” فإن المؤلف تناولها لكونها دراسة خاصة بالإسكندرية.
ويرى المؤرخون أن حفر ترعة المحمودية من إنجازات محمد علي باشا المائية الكبيرة، حيث تعددت أهداف استخدامها من ري الحقول والبساتين التي استصلحها الباشا، إذ كان لنقل الغلال وغيرها إلى الإسكندرية بوسائل أسهل وأقل تكلفة أهمية كبرى، بما يستغني عن إرهاق الفلاحين في عملية النقل عبر البغال والجِمال والحمير.
وعلى الرغم من أن ترعة المحمودية سهلت النقل في تصدير الغلال والقطن، فقد واجهت القناة بعض الانتقادات، ولكن هذا لم يقلل من دورها الكبير في إرساء إمبراطورية الباشا، فضلا عن دورها الكبير في التوسع الزراعي الذي أضفى ازدهارا وتعميرا للمنطقة.