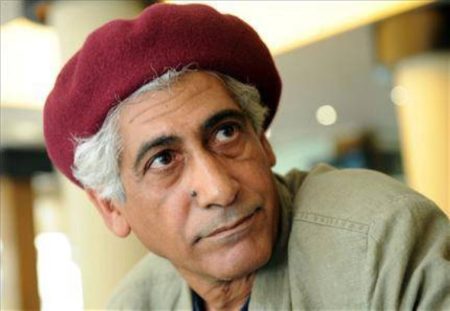في القرن الـ16، سيطر البيوريتانيون (التطهريون) على برلمان الثورة التي قادها الضابط ورجل الدولة والسياسي البريطاني أوليفر كرومويل (1599-1658) في إنجلترا. وبعد فتوى الإصلاحي البروتستانتي الفرنسي جون كالفن (1509-1564) بإباحة الربا، استقدم البيوريتانيون صرافين ومقرضين يهودا من هولندا إلى إنجلترا لتأسيس صناعة صرافة ومؤسسات إقراض.
وتزامن ذلك مع مرحلة هامة من إحياء التوراة وأسفار العهد القديم في الحياة الدينية المسيحية الأوروبية بتأثير “الإصلاح” البروتستانتي الباحث عن مرجعية مقدسة موازية لمرجعية الكنيسة الكاثوليكية، تلتها مراحل أخرى أفضت إلى “المبشِرين الإيفانجيليين” بالقرنين 19 و20، الساعين بلا كلل إلى إدخال اليهود في المسيحية واعترافهم بـ”مسيانية” يسوع الناصري في سياق تحقيق نبوءات يؤمنون بها، فقاموا بالترويج للفكرة الصهيونية وتبنوا مشروع الدولة اليهودية بفلسطين، وربطوا هجرة اليهود إلى فلسطين بنبوءات آخر الزمان وعودة المسيح (عليه السلام) آخر الزمان ومعركة “هرمجدّون” الفاصلة بين الخير والشر في “الأرض المقدسة” ويعقبها ألف عام من الحياة السعيدة (العقيدة الألفية)!
واستعار الاستيطان الأوروبي سيرته ورحلته وديباجاته من نصوص التوراة وقصصها وأبطالها ورموزها وقيمها وجغرافيتها. واستمد المهاجرون الأوروبيون، خاصة البروتستانت منهم، رؤيتهم الكونية والأخلاقية وسرديتهم الدينية من نصوصها، وتماهوا تمامًا مع روح القصص العبرية، واعتبروا أنهم قد خرجوا من أوروبا، مما يشبه الأسر الفرعوني لبني إسرائيل (في مصر التوراتية) إلى “أرض الميعاد” في العالم الجديد.
الإبادات الثلاث
بل إن بعض المستوطنين الأوائل كتب عهدا على السفينة التي ذهبوا بها لأميركا الشمالية، يشبه عهد الإله “يهوه” لبني إسرائيل، كما هو في نصوص “العهد القديم” وقد هاجروا لأنهم أرادوا تأسيس ما اعتبروه “إسرائيل الجديدة” في العالم الجديد. وانطلقت أيديولوجية الاستيطان التي أسست فكرة “أميركا” وهي المعادل الإنجليزي لفكرة “إسرائيل الأسطورية” بقوة دفع بروتستانتية عاتية تقوم على: احتلال أرض الغير، واستبدال شعب بشعب، واستبدال تاريخ بتاريخ. وكل منها مشروع إبادة قائم بذاته.
والراجح أن هذه الإبادات الثلاث ومبدأ الاحتلال والاقتلاع والعنف بالإضافة إلى ركائز المشروع الغربي الرئيسة: الإمبريالية والرأسمالية والعنصرية والفاشية، هي “القيم المشتركة” بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، كما يزعم الصهاينة في أميركا والكيان الصهيوني لتبرير علاقة التحالف بينهما، والانحياز الأعمى لهذا الكيان وصفقات السلاح وترسانة العنف والإبادة التي تزوده بها أميركا.
ويذكر منير العكش أن الفيلسوف البريطاني المعاصر بجامعة أكسفورد، ريتشارد سوينبورن، يبرر فكرة الذبح عند اليهود وفكرة التحريم القائمة على الذبح والحرق، ويرى أن ذبح الفلسطيني على يد اليهودي تكريم للفلسطيني. بل يرى أن واهب الحياة له الحق في استردادها وهو وكل شعبه (اليهود) باسترداد حياة هؤلاء، لذلك لا عتب على الإسرائيلي لقتله الفلسطينيين، فهو يتصرف بناء على أمر من واهب الحياة! وهذه المقولات تعكس تيارا كبيرا. ويبرر سوينبورن (حق اليهود في) القتل على قاعدة التوحيد، مع أن اليهود في تاريخهم لم يكونوا موحدين، فالتوحيد لديهم أن الله لهم وحدهم دون الناس. وهذا ليس له علاقة بالتوحيد.
وقد امتلأ خطاب المستوطنين البيض في أميركا بتعبيرات “أرض الميعاد” و”ميثاق الرب” و”شعب الله المختار” والاستكشاف وارتياد التخوم والغزو وإبادة السكان الأصليين. ورافق ذلك اعتقاد بفرادة تاريخية إلهية لتجربة الاستيطان وأنها جزء من أجندة الرب، وأن أميركا بتعبير الكتاب المقدس “مدينة على جبل” و”منارة بين الأمم”!
وقد نشأ الدين المدني الأميركي، دين الدولة الأميركية، وخاصة مؤسسات “العدالة” والإدارة والشُرطة وفرض القانون والعلاقة بالآخر، عن أيديولوجية المستوطنين “البيوريتانيين” الأوائل الذين طردوا من إنجلترا بعد انهيار ثورة كرومويل، مُكرسًا فكرة أن يهوه “رب العهد القديم” بعنصريته وعنفه وشراسته هو “المرجع الأعلى”! وهذا يفسر شراسة الدولة الأميركية وعنفها وسلطويتها وعنصريتها وعدوانيتها وغشمها وتطرف منظومتها القانونية. وقد أكد حاخام مهم -في كتاب عن تاريخ اليهود بأميركا- أن الأميركيين “أكثر يهودية منا” لأنهم “تبنوا كل أفكارنا” مقارنا بين “يهود الجسد أي أميركا، ويهود الروح الذين هم نحن”.
نفي التكريم الإلهي والاستخلاف
تضافرت إذن مختلف آليات التاريخ والاجتماع وروافد الثقافة والدين والفلسفة في التجربة الغربية بالقرون الخمسة الأخيرة باتجاه صياغة رؤية كونية ومعرفية تواكب وتخدم المشروع الإمبريالي الاستيطاني الرأسمالي العنصري الغربي، وتتماهى مع منطلقاته وفرضياته الكامنة والصريحة وآليات عمله ومآلاته الكارثية عالميا.
وقد أطلق عبد الوهاب المسيري (1938-2008) على هذه الرؤية مصطلح الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية، تقوم على إنكار التكريم الإلهي للإنسان، ونفي استخلافه في الأرض، ومركزيته في العالم، مُحصّنا بالشريعة الإلهية من الظلم والقهر والاستغلال والإبادة والمعاملة المهينة وانتقاص إنسانيته، ضمن تصور معرفي رباني إنساني هو ثلاثية “الغيب والإنسان والطبيعة” كما سماها محمد أبو القاسم حاج حمد (1933-2004) في “العالمية الإسلامية الثانية” (1979) حيث الإنسان ليس إلها بل أكرم مخلوقات الإله ﷻ، ويحقق قمة تألقه ورقيه وإنسانيته عندما يتمثل كونه عبدًا لله.
فالإنسان ليس جزءا من الطبيعة لأن التكريم الإلهي والاستخلاف حصّنه ضد الانتهاك والاستهلاك وأنماط استغلال الطبيعة، بل إن الكون والطبيعة مسخران للإنسان ضمن معايير الحفاظ والاقتصاد والاعتدال وعدم الاعتداء والإسراف في الاستعمال والاستهلاك. وهذا ما يفسر عنف الغرب ضد الإنسان وضد الطبيعة وما نجم عنه من استنفاد مواردها وتدمير منظومات البيئة واحترار الكوكب والتطرف المناخي ودورات الجفاف لأن صعوده لم يكن ربانيا محكوما بالوحي والهدي الإلهي، كما لاحظ سيد حسين نصر (1933) ولم تنطلق نهضته من الربانية والاستخلاف الإلهي، بل من مرجعية ذاتية وتمرد على الألوهية.
المركزية الأوروبية
المركزية الأوروبية أو الغربية رؤية عالمية متحيزة ومتمركزة حول الذات الأوروبية والحضارة الغربية. ويختلف نطاقها من الغرب بأكمله إلى أوروبا فقط أو حتى أوروبا الغربية حصريًا. ويشير تطبيق هذا النمط من التحيز على التاريخ إلى موقف اعتذاري أو تبريري تجاه الاستعمار الأوروبي وديباجاته (مبدأ الحرب العادلة، عبء الرجل الأبيض، إلغاء العبودية، مطاردة القراصنة، حرية الملاحة، إنفاذ القانون) وغير ذلك من أشكال الإمبريالية. وتحيل المركزية الأوروبية إلى توكيد النموذج الغربي وتعميم هيمنة الغرب على العالم والسيطرة على تبادل الأفكار لتوكيد تفوق منظور واحد ومقدار القوة التي يمتلكها على مختلف الأمم والجماعات البشرية.
وتنسحب المركزية الأوروبية على كافة مناحي المعرفة وتؤدي دورا رئيسا في تشكيل الرؤية المعرفية الإمبريالية، التي تركت بصمتها على الأنثروبولوجيا (كمجال معرفي بدأ استعماريا خالصا بالقرن 19 قبل تحريره في العقود الأخيرة) والاستشراق والآثار ودراسات العهد القديم والدين وتاريخ الشرق الأدنى القديم، خاصة تاريخ مصر وفلسطين، وأنتجت سردية تاريخية تصادر تاريخهما الحقيقي وتفرض عليه قسرًا أو حصرًا قصص بني إسرائيل في العهد القديم؛ من ناحية أخرى، تصادر تاريخ بني إسرائيل لصالح “تاريخ يهودي” مزعوم وشعب يهودي مزعوم!
وقصدت تلك الدراسات التاريخية (المشبوهة) أن تنشّئ للجماعات اليهودية الأوروبية حقًا تاريخيًا في الشرق الأدنى القديم لا يقتصر على فلسطين بل يبدأ من ضفاف نهر النيل والدلتا المصرية ليشمل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا وجنوب الأناضول وضفاف نهر الفرات في العراق تحت مسمى “أرض إسرائيل” ليصبح المشروع الاستيطاني الصهيوني الإمبريالي في فلسطين الوريث الشرعي التاريخي للشرق الأدنى بأسره! أي أن المشروع الإمبريالي في المشرق العربي بدأ باستيطان التاريخ والجغرافيا والآثار وأسماء المواقع وصولا إلى أزياء العروس الفلسطينية والفلافل والحمص والتبولة والكسكس والشاورما، قبل وبعد مجيء طلائع الغزو والاستيطان الصهيوني الأوروبي.
وقد كشفت دراسات ما بعد الكولونيالية عن ارتباط وثيق بين دراسات الاستشراق ومنظومة السلطة والسيطرة الإمبريالية الأوروبية. وتولت هذه الدراسات تنميط و”شرقنة” الشرق ليكون بـ”تخلفه” و”لاعقلانيته” مستحقًا للاختراق والاستعمار والاستيطان. فكان كثير من تلك الدراسات الاستشراقية، خاصة الأنجلوساكسونية والفرنكفونية، في خدمة المشروع الإمبريالي الغربي إلا قليلا. وقد خصص كيث وايتلام، أستاذ الدراسات الدينية بجامعة ستيرلنغ بأسكتلندا، كتابا كاملا بعنوان “اختلاق إسرائيل القديمة طمس التاريخ الفلسطيني” لكشف هذا الزيف والتحيز المعرفي!
وقد جندت أجهزة الاستخبارات والاستعمار الأوروبية، من الجمعيات الجغرافية والتاريخية، بعض أولئك “الباحثين” في خدمة استخباراتها ودبلوماسيتها وجهودها لاختراق المشرق والمغرب وتكوين شبكات الموالين لها، في صورة رحالة ومستكشفين وقناصل ومستشارين لأمراء محليين. بل تولى بعضهم تنظيم وهيكلة الدول القطرية العربية الناشئة وتقرير حدودها وتصميم مشكلاتها الحدودية وعلاقاتها ومنظماتها الإقليمية. بل إن مسودة الدستور العراقي الراهن قد صاغها الأكاديمي الأميركي نوح فيلدمان، لتعكس توجهات الاحتلال والحاكم الأميركي بول بريمر، نحو هندسة العراق (الجديد) سياسيًا واجتماعيًا وانقسامًا وصراعًا أهليًا ومحاصصة طائفية وجمودًا تنمويًا.
الاختزال والتنميط والإمبريالية
تتسم الرؤية المعرفية الإمبريالية أيضا بعنصريتها واختزالها وتنميطها البالغ للظواهر الإنسانية والاجتماعية والحضارية، ونزوعها إلى العنف والإبادة، وإنكار وجود الآخر أو نفيه، وضيق مساحة التنوع. ورغم مزاعم الحرية والتعددية، فإننا لا نجد تعددية المثال (ideal) بل هي تعددية ضمن مثال واحد لا يمكن الخروج عنه. وهذه السمة كامنة أيضا في نموذج الدولة القومية الأوروبية الحديثة بسلطويتها ومركزيتها، والتي لا تعترف بتعدد الظواهر الإنسانية والاجتماعية والثقافية ولا تقبل اختلافات أو نتوءات أو هويات محلية أو ولاءات فرعية، بل تميل إلى سحق التنوعات والخصوصيات الثقافية وتهميش الأطراف لصالح المركز.
وبسبب هذا الاختزال في الرؤية المعرفية الإمبريالية وبسبب ضيق نموذجها الكامن -كما لاحظ المسيري- لا يمكن فصل المعدلات المتصاعدة للفردية الغربية عن التوجه الاستهلاكي الحاد بالمجتمع الغربي الحديث، ولا يمكن فصل كليهما عن التجربة الإمبريالية للغرب الشره حين “حوسل” العالم بأسره وحوله إلى مادة استعمالية استهلاكية. كما لا يمكن فصل الرخاء والرفاهية والتنمية في الغرب عن عملية النهب الكبرى و(اقتسام العالم) التي قامت بها الإمبرياليات الغربية التي ليس لها نظير في التاريخ من ناحية اتساع المجال والمنهجية.
وليست الإمبريالية أحد تجليات أو تمظهرات الأيديولوجيا الغربية فحسب، بل هي عند المسيري جوهر الرؤية الغربية الحديثة، وأكثرها تصديقاً لمقولاته الأساسية بشأن العالم أو (العلمانية الشاملة) ويرى أن الغرب سعى من خلال الإستراتيجية الغربية الإمبريالية إلى صيغة تمكنه من الدخول في علاقة لا تتسم بالندية مع بقية العالم، وتهدف إلى تحويل العالم كله إلى مجرد مادة استعمالية توظف لمصلحة الأقوى أو الغرب، ويتحول العالم لمجرد أسواق لسلع الغرب ومصدر للمواد الخام والعمالة الرخيصة. وهذه الإستراتيجية حققت الغرب تراكمه المادي، ومن ثم لا يمكن إغفالها لدى دراسة أي ظاهرة غربية حديثة. ولا بد من استرجاع الإمبريالية لا على أنها مجرد ظاهرة سياسية وإنما على أنها مقولة تحليلية لمعظم الظواهر الغربية في القرن الـ19.
وتفسر الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 5 قرون من تاريخ الغرب وسلوكياته، عنفًا وعدوانية وهمجية وعنصرية. وأنتجت هذه الرؤية المعرفية النظام الدولي ومنظومة الاستيطان والإمبريالية العالمية التي تطحن العالم وتذيق الإنسانية ويلات لم تتوقف منذ سقوط غرناطة وانطلاق موجات الاستكشاف والاستعمار والاستيطان في القرن 16، ولن يعرف العالم سلاما أو عدلا أو استقرارا ما لم تتفكك هذه المنظومة ومقوماتها وفرضياتها وآليات عملها وتتحرر الإنسانية منها، وقد ثبت استحالة التعايش معها أو تحقيق أي تحرر ونهوض إنساني في ظل هيمتنها.
وعام 1958 صدر للشاعر والروائي والناقد النيجيري ذائع الصيت تشينوا أتشيبي (1930-2013) روايته الأشهر “الأشياء تتداعي” (Things Fall Apart) والتي تصف تفكك المنظومة الاستعمارية البريطانية وأسس بقائها غرب أفريقيا، مما أفضى نهاية المطاف لاستقلال نيجيريا وأقطار غرب أفريقيا.
والناظر في مسارات ومآلات الرؤية المعرفية الإمبريالية، وتداعياتها التاريخية، يدرك أن التاريخ لا يعود إلى الوراء، وأن هذه المنظومة في سبيلها إلى “التداعي” والتفكك كما تداعت وتفككت منظومات الشرك والجاهلية وإمبراطوريات الاستعباد والقهر بعد نزول الوحي الكريم قبل 14 قرنًا وصعود الرؤية الكونية التوحيدية وسردية النبوة ومنظومة الهدى ودين الحق. وكان أول الوحي نزولا رؤية معرفية هي نقيض الرؤية المعرفية الإمبريالية بمختلف صورها وتمثلاتها، ألا وهي الجمع بين القراءتين: قراءة كتاب الوحي وقراءة كتاب الكون، وهذا يستحق معالجة وافية إن شاء الله.
- الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.