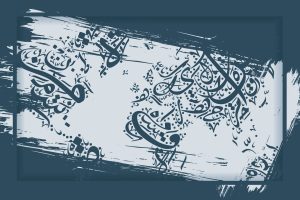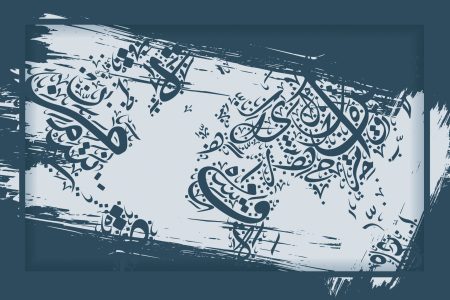أثار تنظيم امتحانات الشهادة السودانية (الثانوية العامة) هذا العام جدلا واسعا لأسباب عديدة تتصل بالوضع الأمني المتدهور والحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، والتي تغطي رقعة واسعة من مناطق البلاد.
وترتب على ذلك عمليا إجراء الامتحانات في الأماكن الآمنة التي يسيطر عليها الجيش، وتعذرها في مناطق انتشار قوات الدعم السريع في دارفور والجزيرة والخرطوم، ما تسبب في حرمان أعداد من الطلبة من الجلوس للامتحانات (تقدر بـ30% من إجمالي الذين سجلوا لجلوسها قبل اندلاع الحرب بحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم).
وقد أفضى هذا الوضع إلى تباين الموقف في الفضاء العام من إجراء الامتحانات في ظل هذه الحرب واختلاف في وجهات النظر، فالإجراء في نظر المعترضين عليه “شكل من أشكال التمييز وعدم المساواة في فرص أداء الامتحانات”، ويثير مخاوف تتعلق بجودة وعدالة الامتحانات واحتمال تسرب أسئلتها بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة، وهو لا يراعي “عدم توفر الظروف المناسبة للطلبة للتحضير الجيد لها”، وأن “وصولهم إلى مراكز الامتحانات يعرضهم لمخاطر أمنية”، وأن الامتحانات قد تتحول -هي الأخرى- لأداة تكرس واقع الحرب.
وكنتيجة لهذه الآراء، دعت بعض الجهات النقابية إلى تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى حين توفر ظروف أمنية أكثر ملاءمة، وارتفعت أصوات تطالب الجيش وقوات الدعم السريع بتوقف القتال خلال فترة الامتحانات ضمانا لسلامة الطلبة. وأُثير، من زاوية أخرى، جدل حول مدى صحة وعدالة إجراء امتحانات الشهادة السودانية في ظل الظروف الراهنة، ومخاوف من تأثير ذلك على مستقبل الطلاب والعملية التعليمية في البلاد.
استجابة لأهمية تحرير القول في هذه الاستشكالات، تعالج هذه المقالة بشكل أساس قضية مواصلة التعليم في ظل النزاع عموما وفي سياق حروب السودان السابقة والتحديات التي أثارتها الحرب الحالية على وجه الخصوص. والهدف الذي ننشده هو التنبيه على بعد تحليلي مهمل في تناول قضايا الحروب والنزاع المسلح المتطاول في السودان، بعدٌ يتصل بغياب وظيفة التفكير المهني في الشأن التعليمي وسياساته في فترات النزاع، المجال الأقل اهتماما من قبل السياسيين وصانعي القرار عادة.
وبمستوى ثانوي، يعترض المقال على ادعاءات شعبوية عبأت الفضاء العام بشعارات من قبيل “لا تعليم في وضع أليم” الذي يهدف إلى كسب التأييد الشعبي دون تقديم حلول عملية أو رؤية شاملة لتطوير التعليم. ومن المهم أن نفصح ابتداء أننا نستبطن في هذه المعالجة رفضا للمقاربات التي تبنتها منظمات الغوث الإنساني الدولية في فترات سابقة في السودان، لكونها تنظر إلى التعليم بمنظور تنموي يُرجي تدابيره إلى ما بعد انتهاء النزاع والحروب وتحقيق السلام.
وظيفة التفكير في الشأن التعليمي في ظل الطوارئ
ربما يكمن سبب إهمال السودانيين لوظيفة التفكير في الشأن التعليمي في أن التعليم، بجانب كونه صناعة لها مبادئ وقواعد، ينمو “حيث يكثر العمران وتزدهر الحضارة”، بعبارة العلامة عبد الرحمن بن خلدون.
ذلك أن هذا الاستقرار المفضي للتنمية والعمران هو الغائب في فكر التربويين والسياسيين على السواء، وهو في المقابل الأمل المنشود في حياة السودانيين. ذلك بالإضافة إلى أن السودانيين، وإن نجحوا في الانفتاح مبكرا على الفكر التربوي العالمي، منذ ثلاثينات القرن الماضي، وتوّجوا ذلك بتجربة رائدة في التعليم بمعهد بخت الرضا في 1934م، لم يطورا فكرا تربويا سودانيا يعالج قضايا التنوع الثقافي وإشكالات التنمية والوحدة الوطنية؛ وهي القضايا الكبرى، ذاتها، التي لازمت فشل النخبة السياسية منذ الاستقلال في العام 1956م وإلى اليوم (أُعلن الاستقلال في 19 ديسمبر 1955م، وتم الجلاء ورُفِع العلم السوداني في 1 يناير 1956).
والحال كذلك، فإن على الأكاديمية السودانية أن تفيق من صدمة الحرب التي انطلقت شرارتها من عاصمة البلاد، الخرطوم، في 15 أبريل 2023، فغطت رقعة عريضة من جغرافيا الوطن، وأن تخلع عباءة السجال السياسي لتمسك بوظائف الدولة والقضايا الوطنية الحقيقية التي تناسب أدوار الأكاديميين ووظائفهم، قادة للفكر وصناعا للقرار الرشيد.
لا شك عندي أن الطريقة التي ظلت تُعالج بها قضايا التعليم خلال الحرب الحالية تعبر عن كثير من الإرباك وضعف الأداء المهني، وإن كانت صدمة التمرد تبرر ذلك الإرباك في الشهور الأولى من اندلاع الحرب فإن الخوف أن يستمر تغييب التفكير في سياسات التعليم ومنهجية إدارته في كل مراحله في فترات الطوارئ، على النحو الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، فتغييب التعليم خلال هذه الحرب لا يقل خطره عن تجميد الدولة وعسكرة الحياة العامة، بحيث لا ينشغل الناس إلا بأخبار المعارك والاقتتال إلا في نطاق خدمي محدود ضيق.
وفي حال صحت هذه المقدمة، فإن تحرير العلاقة بين الحق في التعليم في زمن الحرب والنزاع المسلح من جهة، وترشيد الخطاب السياسي من جهة أخرى، إن لم يُحتكم فيه إلى الفكر المنهجي الموضوعي انتهينا إلى سجال عبثي، يمثل هو الآخر مظهرا من مظاهر الخلاف المفضي إلى مزيد من النزاع وعدم الاستقرار.
وحسنا فعلت وزارة التربية والتعليم أن جعلت انعقاد امتحانات الشهادة السودانية أمرا واقعا، ابتداء من يوم السبت 28 ديسمبر 2024، فهي وإن تأخرت استجابتها في هذا الصدد إلا أن هذه الخطوة من الأهمية بمكان تأكيدا لاستمرار تقديم خدمة التعليم في ظل الحرب وعدم السماح لتداعياتها أن تصادر أمل الأجيال الناشئة في مستقبل أفضل، إذ لا مستقبل من غير تعليم يُنير العقول ويهذب الأخلاق ويعمر النفوس والأوطان.
ولعلي أنبه، في هذا السياق، إلى أن هذه الامتحانات، التي سوف تنتهي يوم الخميس التاسع من يناير 2025م، هي امتحانات دفعة العام 2023 التي كان مقررا لها، قبل اندلاع الحرب، أن تنتظم في 10 يونيو من نفس العام (بعد أن تم تأجيلها من 27 مايو 2023 بسبب تأخر بعض الولايات في إكمال المقررات الدراسية).
وهذا يعني أن تلك الامتحانات أصبحت واقعا بعد سنة ونصف عن موعدها، وهو مظهر من مظاهر العجز عن سرعة اتخاذ قرار استمرار التعليم وإدارة شؤونه في ظروف استثنائية. وقد وقع شيء من ذلك إبان جائحة كوفيد-19 عندما ارتبكت العملية التعليمية ولم تواكب إدارات التعليم في البلاد البدائل التقنية ولا أساليب القياس والتقويم الأكاديمي التي سارت عليها أنظمة التعليم في الإقليم والعالم يومها.
وقبل ذلك تعثر التعليم متأثرا بحراك ديسمبر 2018 وما تبعه من تغيير سياسي وأحداث في العام 2019. ولا يبدو، رغم كل هذه الأحداث والظروف غير الطبيعية، أن من هم في قمة هرم القرار التربوي قد أخضعوا الطُرُق التي تعاطت بها وزارة التربية والتعليم لتقييم شامل، لاستخلاص الدروس والتعلم من تلك الأزمات ورسم سيناريوهات لحالات الطوارئ الشبيهة في حال وقوعها مستقبلا.
وهذا ما يفسر، بجانب صدمة وقوع الحرب في عاصمة البلاد، بطء إيقاع معالجة امتحانات الشهادة السودانية للعام 2023 قبل أن تتوسع رقعة الحرب في ولايات خارج العاصمة الخرطوم. والأمل أن تُعقد امتحانات دفعة 2024 في مارس 2025 -كما قيل- وأن تتدارك الوزارة ما يمكن تداركه.
إن ما نوهنا إليه أعلاه من ملاحظات لا يقلل من الأهمية الكبيرة لتنظيم امتحانات الشهادة السودانية (الثانوية العامة) في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، فهي تعبير عن تمسك السودانيين -في الداخل خاصة، وفي دول النزوح- بالحياة في ظل الحرب مقابل اليأس والاستسلام.
أما الاعتراض على إجلاس الطلبة، بنين وبنات، من كل ولايات السودان، لهذه الامتحانات في المناطق الآمنة فهو اعتراض لا تسنده حجة ولا تبرره تجارب التعليم في ظل النزاعات المسلحة، ولا المواثيق القانونية الدولية والأدبيات ذات الصلة.
فقد قيل إن انتظامها في المناطق الآمنة يعبر عن “ملامح تقسيم السودان” الموحد سياسيا، وانقسامه فعليا ما بين مناطق يتوفر فيها التعليم وأخرى للنزاع المسلح، خاصة في ظل رفض القوات المتمردة انتظام الامتحانات في المناطق التي تنتشر فيها هذه المليشيا، وبذلك -في رأي بعض الكُتاب- تكون قد فقدت السلطة المركزية، التي تمثلها حكومة البلاد، رمزا مهمّا من رموز السلطة المركزية.
يظهر تهافت هذا التوظيف السياسي المتعجل لحق هؤلاء الشباب في مواصلة التعليم والجلوس لهذه الامتحانات، التي تتيح لهم فرصة المنافسة الشريفة للالتحاق بالمرحلة الأعلى في طلب العلم والاستزادة منه، من أكثر من وجه. فهو -أولا- يغفل أن هذا الحق تكفله قوانين ومواثيق دولية، ليس آخرها إعلان المدارس الآمنة (Safe Schools Declaration)، في جنيف، مطلع عام 2015، الذي “يحدد التزامات حماية التعليم من الهجوم، ومنع الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات، وإتاحة الوصول العادل إلى التعليم للجميع حتى في خضم النزاع المسلح والحروب”.
وهو -ثانيا- اعتراض يستنكر صنيع الطرف الذي يوفر مقومات إجراء الامتحانات في مناطق آمنة ويتجاهل إدانة الطرف الذي يعيق حق هؤلاء الشباب في مواصلة التعليم، بمنعهم أو ابتزازهم واضطهادهم.
وهو -ثالثا- يختزل شبهة ملامح الانقسام في “ثنائية أماكن للتعليم وأخرى للنزاع العسكري”، ويغفل أن إعلان القوات المشتركة الدارفورية وانحيازها الفعلي لمساندة الجيش السوداني قد صعب عمليا فكرة انقسام إقليم دارفور عن السودان، وذلك ما تعززه وقائع يوميات الحرب التي شهدتها مؤخرا مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور وحاضرة الإقليم.
إذ لا شك أن صد القوات المشتركة عدوان قوات الدعم السريع المتمردة واستبسالها في الدفاع عن دارفور يمكن وصفه بأنه يمثل للقوات المشتركة قضية وجودية تجعل سيطرة المليشيا على هذا الإقليم أمرا متعذرا بعيد المنال.
وصل الإرث التربوي السوداني بالتحديات الراهنة
تتمثل أهمية امتحانات الشهادة السودانية خلال هذه الحرب في كونها تستحضر -من منظور مهنة التعليم- ذاكرة إرث تربوي سوداني تُوج في منتصف أكتوبر من العام 1962 بإصدار القانون المنظم لامتحانات السودان بأمر جمهوري واصفا الامتحانات بأنها “مسؤولية قومية”، وأن اللجنة التي تضطلع بأعبائها -بحسب ذلك القانون- “تتسم بالأداء المسؤول والكفاية العالية”، “وتكفل العدالة الاجتماعية”، إذ يناط بها تحقيق مبدأ تكافؤ فرص الاستحقاق والمحافظة على المستوى العلمي وحمايته من خطر الفساد.
إن تمثل تلك القيم التي جاء القانون على ذكرها وتجسيدها واقعا تشهد عليه السمعة التي حظيت بها الشهادة السودانية، داخل البلاد وخارجها، والأداء التعليمي عموما لعقود مضت، ولهذا فإن المحافظة على تلك القيم -لا على الشكل الإجرائي للامتحانات- مسؤولية وطنية ومهمة كبرى في كل الظروف. أما مسألة تصور الكيفية الإجرائية لإنجاز تلك المهمة فإنه يختلف بالضرورة في فترات السلم عنه أثناء النزاع المسلح.
من ناحية أخرى، فإن هذه الحرب تنبهنا إلى جملة من الأولويات التي يجب أن تتولى جماعة من التربويين وأهل الاختصاص التفكير المهني فيها، ليس فقط لتأمين الحق في التعليم خلال الحرب والنزاع المسلح، بل لتعزيز دور التعليم في استدامة السلام والأمن والاستقرار والرخاء كذلك. وعلى رأس الأولويات التي يجب إعادة التفكير فيها تأتي قضية المركزية الإدارية للتعليم، لكونها تعالج الكثير من مطالب من حملوا السلاح في تاريخنا المعاصر.
واللامركزية وإن كانت من المباحث التي تطرق المسؤولون عن التعليم لدارستها واتخاذ قرارات في شأنها في بداية حكم جعفر النميري (مايو 1969-أبريل 1985)، وبالأخص في السبعينات عندما اتخذها النظام أسلوبا في الحكم والإدارة، إلا أن تلك التجربة تأرجت بين المركزية واللامركزية بمحاولة توفيقية. والسبب في ذلك، على الأرجح، عائد إلى طبيعة نظام مايو، فهو مثل غيره من الأنظمة الشمولية القابضة على السلطة في شؤونها السياسية والإدارية في عاصمة البلاد يحذر المضي قدما في فلسفة للحكم تشرك الوحدات المحلية بالأقاليم في السلطة، إلا في بعض الأمور.
إجمالا، لقد تأرجح النظر المايوي يومها بين الأخذ بحسنات “لا مركزية التعليم” واعتبارها “تناسب ما حدث من توسع في مجال التعليم، وعلى أساس أن ما ينتظره من تطوير لا بد من معالجته على مستوى الإقليم”، وأن اللامركزية “تتيح الفرصة للمواطنين لمحاولة البت في مشاكل التعليم واختيار الحلول المناسبة لحاجة أبنائهم، وبذلك تتفرغ الإدارة المركزية للاهتمام بالقضايا ذات الطابع القومي والأداء التعليمي العام”. ومن جهة أخرى استحسن نظام مايو “مركزية التعليم”، بوصفها “ضمان الوحدة القومية والتماسك الاجتماعي، وذلك بتوحيد مناهج التعليم وأنظمته وطرائقه ومستوياته”.
والنتيجة، فيما يتعلق بالشهادة السودانية، وحتى العام 1978، “ظلت الامتحانات المرحلية مركزية، باستثناء -في ذلك الوقت- الإقليم الجنوبي في الشهادتين الابتدائية والصغرى، حيث يشرف قسم التقويم التربوي مركزيا على وضع الامتحانات وطباعتها وتوزيعها. وكذا الشأن للتصحيح بالنسبة للثانوي العالي فهو يتم مركزيا، خلافا لما دونه من مستويات التعليم الابتدائي التي اعتمد فيها اللامركزية، تتولى أمره المديريات (المحليات لاحقا)، أما الثانوية الصغرى (المرحلة المتوسطة) فقد حدد لكل مديرية مركز تصحيح واحدا”.
الاستشهاد بحقبة نظام جعفر النميري، في هذا السياق، مقصود به استدعاء حرب الجنوب واستخلاص الدروس منها في قضيتين، الأولى تتعلق بالأسلوب الأمثل في إدارة التعليم في بلد كالسودان، مترامي الأطراف ويتسم بالتنوع الجغرافي والثقافي، والثانية تتصل بمبدأ توفير التعليم خلال فترات النزاع المسلح والنزوح والطوارئ عموما.
لقد تمثل إخفاق الجنوبيين، بحسب تقارير، في تفويت حقهم في التعليم خلال الحرب لأكثر من عقدين من الزمن، في السبعينات والثمانينات، وإلى منتصف التسعينات، هذا على الرغم من أن قضيتهم ظلت حاضرة في بعض مفردات خطاب منصور خالد، إبان تقلده منصب وزير التربية والتعليم في منتصف السبعينات. فالتعليم، بعباراته التي خاطب بها اللجنة الفنية لمشروع المسح التربوي في 10 فبراير 1976، “أداة للتغيير الاجتماعي واستثمار بشري يحسب عائده على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووسيلة مباشرة لتحقيق العدالة في المجتمع وإشاعة المساواة في كيانه”.
غير أن انتظار الاستثمار في التعليم كلف الجنوبيين كثيرا، حيث ظل الوضع التعليمي في جنوب السودان سيئا للغاية، وقد نوهت اليونيسف إلى أن تلك الحرب “قضت تقريبا بشكل كامل على التعليم الثانوي في الجنوب، إلى جانب التعليم المهني والتقني، ومؤسسات ما بعد الثانوية، وتعليم المعلمين، والتعليم العالي وتعليم الكبار”.
قد يبدو أن الإخفاق وقع نتيجة اختلاف فلسفي بين مقاربتين في التنمية والعون الإنساني، لكن -أيا كان- فإنه إخفاق تتحمل وزره الأكبر، في حالة الجنوب، الجهات الدولية المانحة؛ لكونها لم تمول تعليم الجنوبيين خلال الحرب على اعتبار أن “التنمية تتعلق بالاستثمار في المستقبل” وأن “المساعدات الإنسانية تتعلق بإنقاذ الأرواح اليوم”، واعتبار التعليم نشاطا تنمويا لا يُدعم أثناء الحرب.
فقد فاقم إنكار هذا الحق الإنساني الأساس في التعليم الظروف الاجتماعية التي غذت الحرب الأهلية وأسهم في أن تحصد دولة جنوب السودان، بعد الانفصال، أقاليم مدمرة وشعبا غير متعلم إلى حد كبير. وكان أن وقع، من قبل، الانفصال وجدانيا بفضل سياسات الحركة الشعبية لتحرير السودان ومسعاها لتطوير نظام تعليمي خاص بها، ومنفصل عن الشمال.
نحن إذن أمام قضيتين: توفير التعليم خلال الحرب، وبناء وجدان قومي جامع؛ وكلاهما لم يتحققا في حالة جنوب السودان الذي اختار في العام 2011 الانفصال بدولة مستقلة. أما إذا أمعنا النظر في حالة أخرى واستدعينا وضع التعليم خلال النزاع المسلح في جبال النوبة، فالأمر -فيما يبدو- لا يختلف كثيرا في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، خاصة فيما يتعلق بوجهة التعليم وفلسفة مناهجه، لكنه يختلف من ناحية مسعى قيادات جبال النوبة لتوفير التعليم أثناء الحرب.
فقد استؤنف التعليم في ظل الحرب بعد توقف دام 7 سنوات في الفترة من 1988-1995 بجهود بعض قدامى المعلمين من أبناء الجبال في مجال الاهتمام بتعليم القراءة والكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية، مع التركيز على اللغة الإنجليزية، ثم الاعتماد على مناهج من دول شرق إفريقيا.
ومن المفارقات، عند المقارنة بين حالتي جنوب السودان وجبال النوبة، أن جنود النوبة كانوا يمثلون العمود الفقري للجيش السوداني الذي قاتل في جنوب السودان في الحرب الأهلية الأولى (1955-1972)، نظرا إلى أن الحرب وقتها كانت تدور من “أجل قضية جنوبية على وجه التحديد”، “دون أي هدف قومي” بحسب وصف الواثق كمير. لكن “منذ منتصف الستينات فصاعدا، بدأ الناشطون السياسيون من النوبة في تأكيد حقوقهم ضد الخرطوم، ودعوا إلى اللامركزية والعدالة الإقليمية”.
وقد تعلقت المطالب الأساسية التي عبروا عنها بـ”الأمن، واحترام الهوية الثقافية، والتهميش الاقتصادي/مصادرة الأراضي، ثم برز منذ العام 1989 -تزامنا مع نظام البشير- الدين كحافز نضالي آخر ضد الخرطوم/المركز”.
يقول أحد رواد التعليم بجبال النوبة: “لقد اعتبرنا أنفسنا خارج الدولة السودانية”، غير أننا “داخل وطننا ووسط الثقافة والتراث النوبي”، الذي -بتعبيره- كان “مهملا في المناهج التي تأتينا من بخت الرضا سابقا، فمناهج السودان لا تهتم بإنسان جبال النوبة”.
الاستنتاج الأهم هنا أن سياسات التعليم ومناهجه وأنشطته المدرسية في كامل سنوات العهد الوطني، بعد الاستقلال، والتي هي انعكاس لفلسفة الحكم في البلاد، لم تعالج فك العزلة التي فرضتها الحياة الجبلية لقبائل النوبة والتي وظفها سلبا المستعمر الإنجليزي لتأكيد حساسية ثقافية بين أبناء الجبال والشمال، حوّلها -من بعد- إهمال الحكومات في المركز لقضايا التنمية في الجبال، وعجزهم عن معالجتها بشكل جدي، إلى شعور بالغبن الاجتماعي شكل هوية نضال أبناء النوبة إلى اليوم.
من منظور الأزمة في دارفور فإن النزاع فيها يختلف عن جنوب السودان وجبال النوبة من عدة وجوه، فالحركات الدارفورية التي حملت السلاح ضد الخرطوم لم تفعل ذلك وفق رؤية واضحة، وعندما حاولت أن تفعل ذلك لاحقا لم تتمكن نتيجة الصراعات والانقسامات، فبقيت دون رؤية إستراتيجية موحدة، على خلاف النزاع في جنوب السودان والجبال والنيل الأزرق الذي التف حول مانفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان.
هذا بالإضافة إلى أن الاختلاف الكبير بين العنف في دارفور والعنف في جنوب السودان تمثل في أن الصراع في دارفور بدأ بحرب أهلية (1987-1989) لم تتدخل فيها الحكومة أصلا، لكنها تدخلت في فترات لاحقة “عندما انضمت الأحزاب السياسية المعارضة لنظام البشير إلى النزاع في الفترة من 2002 إلى 2003”.
ومن ناحية أخرى، فإن التعبئة للحرب الأهلية في دارفور على الرغم من إدارة المؤسسات القبلية لها فإنها -كما أوضح محمود ممداني- “لم تكن حربا في كل مراحلها بين [الأفارقة] و[العرب]”، فهي حرب بين قبائل تمتلك الأراضي (الحواكير) وقبائل لا تمتلكها، وفي بعض الحالات يكون طرفا الصراع قبائل عربية، كما هو الشأن في جنوب دارفور، وفي أخرى يكون أحد الطرفين قبائل عربية وفي الطرف الآخر قبائل غير عربية، كما هو الحال في شمال دارفور.
إن هذا الملمح المهم -كما يرى ممداني- عملت وسائل الإعلام على التعتيم عليه “لإظهار العنف وكأنه إبادة جماعية يرتكبها العرب ضد الضحايا الأفارقة”. ولعله من المهم التأكيد، رغم صحة استنتاج ممداني، على أن اندفاع الحكومة في الخرطوم في التعامل مع أزمات دارفور بدون رؤية أوقعها في ردود أفعال. وقد زادت حكومة البشير الأزمة تعقيدا منذ العام 2003 باستعانتها بمليشيا تنتمي إلى فصيل قبلي عربي، هو النواة التي تطورت لاحقا في قوات الدعم السريع التي تشن الحرب الدائرة حاليا، غير أنها تفعل ذلك لأسباب لا تتعلق بخلفيات التأسيس.

في الختام
إن أزمات النزاع السوداني المسلح مجتمعة، في التحليل النهائي، تدعو إلى التفكير الجدي في إصلاح السلطة في الدولة بالسياسة والقانون، وإصلاح الأمة السودانية بالثقافة والتعليم والتنمية. لذلك من المهم أن يُنظر للتعليم بوصفه أداة للتغيير الاجتماعي والتمكين، وأن تُترجم تلك النظرة بوضع خطط لما يجب تعلمه خلال فترة الحرب هذه، وألا يكتفي الساسة بالخطب فقط، وأن يكف المعلمون وصناع القرار التربوي عن الإصرار على محاولة تغطية كامل محتوى مناهج التعليم التي وضعت لتناسب سياقات مختلفة عن السياق الذي تمر به البلاد حاليا وعن السياق الذي ينتظرها، إعمارا لما أفسدته الحرب في النفوس والمنشآت والبنى التحتية في كافة المجالات.
إن الحاجة لمواكبة التعليم للتحديات الراهنة وللتفكير فيما يجب أن تكون عليه البلاد مستقبلا مهمة لا تحتمل التأخير. يجب أن يتولى التخطيط لها جماعة من التربويين الملمين بأدبيات التعليم خلال الحروب والنزاعات المسلحة، برؤية إستراتيجية شاملة بعد تشخيص الاحتياجات الحالية وبحث تداعيات الحرب والاحتياجات المستقبلية في فترة ما بعد الحرب.
إنها مهمة تتطلب بحوثا تقدم خلاصات مركزة وأمينة للدروس المستفادة من تاريخ النزاع والحروب في السودان استشرافا لمستقبل تسوده قيم السلم وإرادة العيش المشترك والتعمير والبناء، كما تتطلب الالتزام بمنهجية في تصميم برامج التعليم تضم خبراء في التعليم وعلم النفس والتاريخ والعلوم الاجتماعية والتنموية وعلوم الحاسوب والاتصالات. أما إدارة الوضع الراهن فإنه يتطلب الاستعانة بخبراء لوضع برنامج تثقيف لإدارات التعليم ومديري المدارس بما يلزم معرفته من أدبيات التعليم واتجاهاته في ظل النزاع المسلح.