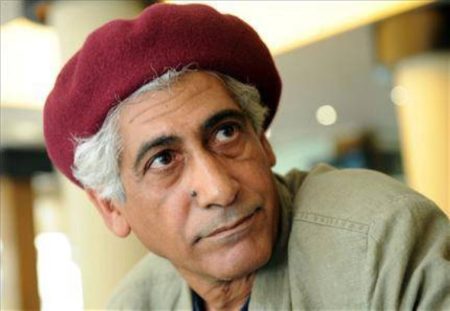لم يتوقف أثر الحرب الأهلية اللبنانية عند الجيل الذي عاشها شابا: جبور الدويهي، رشيد الضعيف، حنان الشيخ وحسن داود وغيرهم؛ بل ظلت الحرب تنتج أجيالا لاحقة ومتلاحقة من الكتّاب والمبدعين اللبنانيين.
ليس لأنها كانت فترة مهمة تاريخيا يعود إليها الكتّاب بما هي معين مدهش للتخييل؛ إنما لأن أوجاعها مستمرة وواقع لبنان وأزماته الراهنة كلها أصلها ممتد إلى تلك الحرب، عبر ساستها ونظامها وأعدائها وتحالفاتها، كما تمثل التروما التي عاشها أطفال تلك الحرب حالة مستمرة؛ إذ وصلنا الآن إلى ما يمكن أن نسميه آخر جيل الحرب، ذلك الجيل الذي ولد أثناء حصار بيروت 1982.
وتعتبر الكاتبة والناشرة اللبنانية عزة طويل واحدة من هذا الجيل الذي ولد في تلك الفترة الحالكة من التاريخ اللبناني والعربي عامة وعاش رعبها ليعيش بعد ذلك بصدمة نفسية (تروما) من جراء الحرب. تقول الراوية: “يقولون إني ولدت في أعنف أيام بيروت، بمجرد انتهاء مجزرة صبرا وشاتيلا، جئت إلى الدنيا، كتعويض عن ولد قُتل في الليلة الفائتة ربما”.
فكيف يمكن لذاكرة التشظي والموت والمدن المتناثرة تحت القصف أن تنتج نصا متماسكا وأي صورة لذلك التماسك؟ من هذه النافذة يمكننا أن ندخل إلى روايتها “لا شيء أسود بالكامل” الصادرة عن دار هاشيت نوفل 2024.
الموت والحرب
تنهض تيمة الموت تيمة مركزية في رواية عزة طويل، وهي تيمة -رغم كثرة تداولها- مصنفة من الفلاسفة ضمن المسكوت عنه أو المحظور عندما يتعلق التوغل فيها بما هو ممنوع سياسيا أو دينيا أو نفسيا.
ومن هنا يمكن أن نقرأ دوافع اختيار تيمة الموت في الرواية كمغامرة فنية ومغامرة لإنتاج المعنى فمن خلالها استطاعت عزة طويل أن تفضح بؤس السياسة وبؤس العادات والتقاليد وبؤس مؤسسات تنحرف وتبقى معصومة ومحمية بتاريخها الأخلاقي كمؤسسة الأب ومؤسسة الأم ومؤسسة العائلة وحتى مؤسسة الحزب والطائفة.
إن هذا الجيل الذي نشأ في الملاجئ كما تقول الراوية لم تمسه الحرب نفسيا فقط؛ بل مسته حتى جسديا وفسيولوجيا فلا أحد ينجو يمكن أن من الحرب. تقول الراوية محدثة صديقها: نعم جميعنا ترعرع في الملاجئ. أتعلم، قد تكون تلك الملاجئ عمليا سبب إصابتنا كلنا بنقص الفيتامين دي”.
تبدأ الرواية بخبر اعتيادي؛ خبر موت والد زوج الراوية، ليتوغّل السرد في عالم الموت ودهاليزه، في الواقع وفي التاريخ، ليكتشف القارئ أن كل شيء يموت في النهاية وبكل قسوة حتى الحق في الموت عندما تصبح عملية الدفن في مدينة عربية كبيروت تحتاج آلاف الدولارات فأنت لست حرا في أن تموت:
“يقول أحد البيارتة إن تكلفة القبر في الباشورة تصل إلى 15 ألف دولار. هناك يحفرون ليدفنوا الميت الجديد في كل عائلة فوق جثث أقاربه. ينتظرون تحلل الجثة الذي يستغرق عامين قبل أن يضيفوا إلى الحفرة ميتا آخر”.
إن المدينة العربية ليست آمنة حتى للأموات، فحرمتهم هي الأخرى منتهكة وليس هناك شيء اسمه “الراحة الأبدية” في مدن تُفتح قبورها ليستقبل الميت السابق عنوة ميتا لاحقا قد يكون عدوا حميما.
لذلك تقول الراوية: “في مدينة مثل بيروت، على المرء التروّي قبل اتخاذ قرار الموت، أما الضيعة، فالأمر أسهل. الأرض أسرع استقبالا للجثث، كما أن التربة أشهى”.
لقد مثل الإجهاض والأمومة الصعبة، في الرواية، جزءا من معاناة المرأة اللبنانية وهو جزء من تروما الحرب والموت أيضا وكأن بالراوية تخشى على أجنتها من أن يخرجوا إلى العالم فتأكلهم الحرب، فالحرب في لبنان لم تتوقف أبدا، وميلاد بيروت من جديد ظل يجهض كل مرة.
التشكيل والتجريب
تشكّل عزة طويل روايتها بما سميناه، في مناسبات سابقة بـ”المقطع المغلق المفتوح”، وهي تقنية سردية تعتمد بناء العمل الروائي على “وحدات سردية” مكتفية بذاتها في ظاهرها، ويمكن قراءتها كما لو كانت نصوصا مكتملة مفردة في تماس مع القصة القصيرة ولكن ضمَّها وقراءتها وفق تلقي فن الرواية يجعل من العمل رواية.
وهي تقنية قديمة ظهرت مع أول رواية في التاريخ “الحمار الذهبي” لأبوليوس واعتمدها بوكاتشو في كتابه الديكامرون وميغيل دي ثيربانتس في “دون كيخوته”. فهي أصل الكتابة السردية والروائية تحديدا عندما يلتهم الجنس الروائي بطبيعته الإمبريالية أجناسا قريبة منه وخاصة القصة القصيرة ويوظفه في بنائه.
وقد وصلت هذه التقنية إلى ذروتها في الاختبار مع الروائي التونسي “صلاح الدين بوجاه” عندما أعاد توظيف قصص له منشورة في روايته “سبع صبايا”، وكذلك فعل مواطنه حسن نصر في روايته “سجلات رأس الديك” التي سبق أن نشرها كقصص متفرقة في مجلات تونسية.
ومن ثم، نحن في الرواية أمام لعب بالأجناس الأدبية وإن كان عنوان السلسلة التي نشرت فيها الرواية “نوفيلا” (قصة طويلة) ما زال ملتبسا ومرفوضا حتى من الكتّاب الذين نشروا في السلسلة، خاصة بعد سوء الفهم الذي صار عند البعض والذين يخرجون النوفيلا من جنس الرواية وبذلك يقع استبعاد العمل من الجوائز الخاصة بالرواية.
وهو ما يتطلب مزيدا من التثقيف بنشر البحوث حول هذا النوع من الرواية الذي لا تحدده أحجام الروايات بل شروط أخرى، وكان يمكن لدار النشر أن تضع بيانا في أول هذه السلسلة كما هو معمول به في تقاليد إطلاق السلاسل الأدبية لتهيئة المتلقي لاستقبال هذا النوع ولكي لا تحدث هذه الفوضى التي رصدناها في الصحافة الثقافية حتى إن ناشرا عربيا آخر وجد نفسه في حرج أمام رفض الكتّاب وضع كلمة نوفيلا على الأعمال التي قدموها للنشر.
ولئن كانت عملية التجنيس الأدبي مسألة ثانوية في تحديد قيمة العمل الأدبي فإن تضخمها في مجتمعات تعاني من أزمة قراءة وتخشى من مجهول المغامرة الأدبية قد يشكّل خطرا على النصوص الجيدة التي قد تجني عليها هذه الإكراهات التسويقية والأحكام المسبقة انطلاقا من العلامة الأجناسية على الغلاف أو عنوان السلسلة.
وبقراءة الرواية واستحضار شروط “النوفيلا” يمكننا أن نجزم بغياب العلاقة بينها وبين هذا النوع الأدبي؛ ونقول إنها رواية تجريبية تشتغل فيها الكاتبة على اللغة متجوّلة في تيمات مختلفة وتتنقل فيها عبر أزمنة مختلفة.
ويبدو هذا التكثيف في الفصول وفي الرواية يشي باشتغال كبير من الكاتبة على نصها لتخلصه من كل الشحوم السردية التي تزدحم بها الروايات العربية ذات الأحجام الضخمة أحيانا. ولعل هذا راجع إلى خبرة الكاتبة في العمل بعالم النشر، حيث سبق أن نشرت أعمالا عالمية في إحدى دور النشر العربية، وهذا التكثيف الذي يشي بجهد طويل في التحرير، أكسب الرواية تماسكا وشعرية فريدة مؤكدا أن الكتابة عملية محو مستمرة وليست تحبيرا.
رواية الأجيال القصيرة
تدخل عزة طويل في الرواية في تحد غريب عندما تستدعي نمطا آخر من الروايات التي تشتهر في الأدب الأميركي وعرفته الرواية الروسية؛ “رواية الأجيال” والتي عرفناها عربيا من خلال ملحمة “الحرافيش” لنجيب محفوظ، ولكن تحدي الكاتبة يأتي من محاولة اختبار هذا النوع من الرواية في الرواية القصيرة، ليطرح السؤال: هل يمكن للرواية القصيرة أن تتحمل برنامج رواية الأجيال؟ سؤال يبقى مفتوحا على التلقي. لكن المؤكد أن الكاتبة استطاعت أن تحافظ على تماسك روايتها وتبني كل تلك المناخات ولو بشكل شذري.
حيث نقلت لنا حركة أجيال من العائلة نفسها عبر فترات زمنية مختلفة تقودها ذاكرة الراوية التي ولدت أثناء الحرب الأهلية اللبنانية. وبين عائلة زوجها في حمص وعائلتها ببيروت راوحت الكاتبة سرد تاريخ العائلتين والمدينتين عبر تناظر محكم بين بيروت وحمص وأبو شادي وزوجته آمال اللبنانية ووالدها وأمها وما تخللها من النفوس والبيوت والأصدقاء من هنا وهناك والجامع بينهم جميعا؛ الحرب والموت بكل ألوانه، حرب لبنان وحرب وسوريا.
إن هذا النجاح الفني الذي تحققه الرواية يشي بتطور ما يسمى بالأدب الوجيز عربيا، وهو حقل يمكن أن يكون مختبرا لتطوير الأدب العربي عامة، اختبرناه مع الفلسطيني مازن معروف في القصة القصيرة والمتتالية القصصية ومع محمد سعيد أحجيوج في الرواية ومن قبلهما جميعا إبراهيم أصلان صاحب “مالك الحزين” و”وردية ليل” و”حجرتان وصالة” والروائي يحي الطاهر عبد الله في روايته “الطوق والإسورة”.
وكان الروائي محمد صلاح العزب قد تبنى هذا التيار في وقت ما من خلال رواياته: “وقوف متكرر” و”سرير الرجل الإيطالي” قبل أن تأخذه السينما والدراما وينهمك في كتابة السيناريو. ومن ثم فإننا أمام تيّار يتجدّد مع كل جيل بأسماء جديدة وبرامج جديدة تأخذ من كاتبها شيئا من الخصوصية.
التخييل الذاتي
إذا كان من أمر واضح متعلق بالتجنيس الأدبي فالرواية تنحو نحو التخييل الذاتي وهو نفسه جنس أدبي رجراج وخلافي حديث ظهر مع سيرج دروبروفسكي سنة 1977 عندما وصف عمله “ابن” أو “خيوط” فكتب على ظهر الغلاف: “سيرة ذاتية؟. كلا… إنها منزلة خاصة بعظماء هذا العالم في آخر أطوار حياتهم. وفي أسلوب بهي ورائق. إنها “تخييل” لأحداث واقعية جدا إذا أردنا… فهي “تخييل ذاتي”، فعل ذلك ضمن محاججة لنظريات لوجون حول السيرة الذاتية والرواية.
والتخييل الذاتي مثله مثل النوفيلا ظل تصنيفا غير مرغوب فيه من المبدعين لأنه يمكن أن يجر شبهة السيرة الذاتية كما تجر النوفيلا شبهة القصة القصيرة، وفي الحالتين عملية خاطئة لأنهما ينتميان للرواية؛ وليس للقصة القصيرة أو السيرة الذاتية.
والتخييل الذاتي في مفهومه البسيط هو سر حكاية بطلها يحمل اسم المؤلف لم تحدث له أبدا أو لم يحدث قسم كبير منها أبدا، حيث يعمل الروائي على التلاعب بالقارئ عبر استدعاء القرائن التي تقول إن العمل سيرة ذاتية؛ بينما هو عمل تخييلي، وما العناصر الأوتوبيوغرافية إلا عملية تمويه فني وفخاخ ينصبها الروائي لقارئه ليشوش عملية التلقي ويدخله في حيرة وتساؤل أثناء إنتاج النص: هل حدث هذا للمؤلف فعلا؟
ولئن كان المغربي عبد القادر الشاوي أجرأ الكتّاب العرب في استعمال هذا التجنيس وكتب عبارة “تخييل ذاتي” على غلاف كتابين “من قال أنا” و”التيهاء”؛ فإن اللبناني رشيد الضعيف كان أكثر الكتّاب العرب وعيا بهذا الجنس وتلاعب به فنيا كما أحب عندما يسمي معظم رواة رواياته أو أبطالها برشيد وأحيانا الاسم كاملا “رشيد الضعيف”؛ كما في روايته “ألواح”، ومع ذلك تظهر كلمة رواية على غلاف العمل.
التخييل الذاتي
وفي رواية لا شيء أسود بالكامل، تتماهى الشخصية الراوية مع الكاتبة في كثير من الأمور: السن، بعض الوقائع كمولدها أثناء الحرب ومجزرة صبرا وشاتيلا، انجابها لفتاتين، سفرها إلى كندا، حديثها عن الروائيين والكتاب ومعرفتها بهم، كما تذكرك الرواية في مواطن منها بروايات أخرى قرأتها ومنها “الصرصار” للروائي اللبناني الكندي راوي الحاج والتي كانت الكاتبة من مدبرات ترجمتها ونشرها بالعربية في بيروت. فتتحدث كل مرة عن الصراصير وارتباطها بالحرب:
“اقشعر بدني مجددا وهو يحكي. خطر لي أن ثمة ارتباطا وثيقا بين الحرب والصراصير، وبينها وبين الموت بالتالي، ثم ابتسمت حين تذكرت أن الصراصير تنقلب على ظهرها حين تموت”.
ومع ذلك فإن الكاتبة تناور حتى في التخييل الذاتي وتنجو منه كل مرة بانتهاكه عندما تترك البطلة بلا اسم ومن علامات التخييل الذاتي تطابق اسم الكاتب مع اسم الشخصية الرئيسية. ولكن بشيء من التأمل سنصل إلى أن تغييب الاسم نفسه للراوية الرئيسية يجعلها تتماهى مع اسم الكاتبة في لعبة ما سماه كولن ولسن بـ”الايهام بالواقعية” كما تفعل الفرنسية آني أرنو صاحبة جائزة نوبل للآدب عندما تستلهم رواياتها القصيرة أيضا من تجاربها الشخصية ومغامراتها العاطفية المعروفة بدون أن تدرج ذلك السرد ضمن السيرة الذاتية؛ فيبقى متأرجحا بين التخييل الذاتي والرواية ليشبع فضول قرّاء السيرة وقراء الرواية.
وتتواصل رحلة اختيارات أنواع الكتابة لتقرع باب السيناريو مرة وباب السيرة مرة وباب القصة مرات ليبدو كأن هناك علاقة بين التفكك المقصود في النص وهذه الضبابية الأجناسية وفضاء الحرب وأشلائه، وهناك علاقة بين تيمة الإجهاض والموت الذي يخيم على النص وفضاءات الموت القديم في الحرب الرابضة في الذاكرة.
فهل في هذا الإيجاز الذي ظهرت به الرواية محاكاة أخرى للفعل الخاطف في الحرب وردود الفعل؟
وكما تُمحى المساكن والمدن بقذيفة واحدة وصاروخ واحد؛ كانت عزة طويل في هذه الرواية تقصف الحرب والموت بقذيفة سردية خاطفة لتدينها بالكامل وبشكل مباغت، لتقول: إن الحرب في لبنان وسوريا وفلسطين واحدة ومستمرة كقدر عابث يسرق أرواح الشيوخ والأطفال وحتى الأجنة في الأرحام.