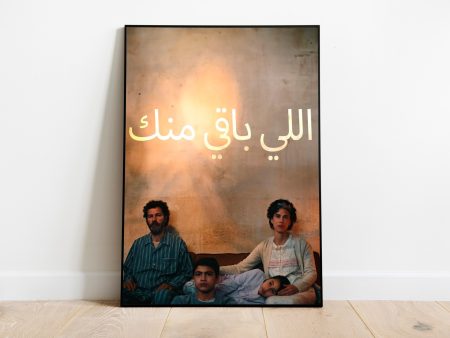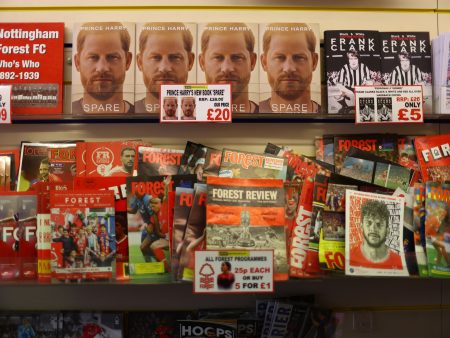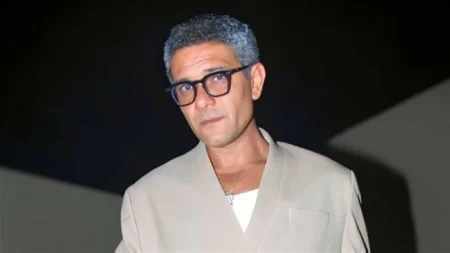كشفت المتخصصة في الأدب الإنجليزي والأمريكي الدكتورة مشاعل الحماد، أن هناك مقالات ومواضيع تصور المسلمين والثقافة العربية بطريقة مختزلة ومليئة بالأفكار النمطية البعيدة عن الواقع، وأن المنهجية المتبعة في تحريف معاني النصوص العربية الأصيلة لتتماشى مع رؤى المترجمين الغربيين وتوجهاتهم الفكرية كانت وراء تخصصها في الترجمة والأدب، لتوضيح وتصحيح الصور المغلوطة لديهم..
• ما أسباب اختيارك الأدب الإنجليزي والأمريكي للترجمة؟
•• بدأ اهتمامي بترجمة الأدب الإنجليزي والأمريكي بمحض الصدفة أثناء إعدادي أطروحة الدكتوراه، رغم أن تخصصي الأكاديمي يتمحور حول أدب القرن التاسع عشر وليس الترجمة، وقادتني رحلات البحث المتكررة إلى المكتبات والمتاحف البريطانية لاكتشاف عالم جديد.. كنت أقضي ساعات طويلة متنقلة بين الرسائل والصحف والوثائق الأرشيفية المكتوبة في القرن التاسع عشر التي لا يمكن الوصول إليها رقمياً، معتمدة على الطريقة التقليدية في تصفح المستندات صفحة تلو الأخرى.. خلال هذه الرحلة البحثية الشاقة، استوقفتني العديد من المقالات والترجمات التي تصور المسلمين والثقافة العربية بطريقة مختزلة ومليئة بالأفكار النمطية البعيدة عن الواقع، وما أثار دهشتي حقاً -رغم معرفتي بتفشي هذه الممارسات إبان حقبة الاستشراق في ذلك العصر- هو تلك المنهجية المتبعة في تحريف معاني النصوص العربية الأصيلة لتتماشى مع رؤى المترجمين الغربيين وتوجهاتهم الفكرية، ومن هنا نشأ لدي شغف بترجمة الأدب، ليس فقط كنقلٍ لغوي، بل كوسيلة لفهم الثقافات وتصحيح الصور النمطية المغلوطة.
• ما أبرز مؤلفاتك وترجماتك في الأدب الأجنبي؟
•• بحكم مجال عملي الأكاديمي، تتمثل أبرز مؤلفاتي في بحوث علمية نُشرت في مجلات أكاديمية مُحكمة، تتناول مجالين رئيسيين؛ الترجمة الأدبية والأدب العابر للمحيط الأطلسي (transatlantic literature).. في مجال الترجمة الأدبية، تعمقت في دراسة سيرة عمر بن سعيد؛ التي تُعد النص الوحيد المكتوب باللغة العربية ضمن أدب العبيد في أمريكا مطلع القرن التاسع عشر. كما تناولت السيرة الذاتية لإيملي روت ذات الأصول العربية؛ التي حاولت من خلال كتاباتها مناهضة الصورة النمطية عن المرأة العربية، رغم أن مساعيها لم تحقق النجاح المنشود آنذاك.
أما في مجال الأدب العابر للمحيط الأطلسي، فقد ركّزت أبحاثي على ظاهرة انتقال النصوص الأدبية بين أمريكا وبريطانيا، وكيفية إعادة تفسير وقراءة النصوص الأمريكية المكتوبة بالإنجليزية عند انتقالها إلى السياق الثقافي البريطاني. طورت في هذا المجال دراسات حول نظرية النص المُحاذي (paratext) وتأثيره على فهم أعمال كتّاب أمريكيين بارزين مثل ولت ويتمان، وهنري لونغفيلو، وفاني فيرن.. تعكس هذه المؤلفات اهتمامي العميق برحلة النص الأدبي عبر الثقافات واللغات المختلفة، وما يطرأ عليه من تحولات دلالية وتأويلية.
على صعيد الترجمات الأدبية، نُشرت لي، سابقاً، ترجمات لقصص آرنست همنغواي في صحيفة «الحياة» السعودية. وبصفتي مترجمة معتمدة من هيئة الأدب والنشر والترجمة، أعمل حالياً على عدة مشاريع طموحة لترجمة روايات ونصوص تاريخية مهمة لا تزال قيد التنفيذ، وتهدف إلى إثراء المكتبة العربية بأعمال أدبية عالمية.
•ما أهم العقبات التي تواجه الترجمة الأدبية؟
•• الترجمة الأدبية تواجه عقبتين رئيسيتين؛ المترجم نفسه، وتعدد التأويلات للنص الأدبي الواحد. في ما يتعلق بالمترجم، يتطلب الأمر أكثر من مجرد إتقان للغتَي المصدر والهدف. إذ يجب أن يكون المترجم الأدبي متمكناً من ثقافة وأدبيات اللغتين، ويمتلك ذائقة أدبية مرهفة تُكتسب من خلال التعمق في قراءة نتاج الأدبين. كما ينبغي أن يكون ملماً بالسياق التاريخي والحقبة الزمنية التي أُنتج فيها النص، إضافة إلى التيارات الفكرية والمذاهب الأدبية التي تأثر بها الكاتب الأصلي. فبعض الكلمات والمصطلحات ربما تختلف معانيها باختلاف الحقبة الزمنية. على سبيل المثال، يشير مصطلح «Jim Crow» في القرن التاسع عشر إلى نوع من المسرحيات التي تصوّر حياة العبيد في أمريكا بشكل فكاهي، بينما غدا في القرن العشرين يرمز إلى قوانين التمييزالعنصري بين البيض والسود، وفي القرن الواحد والعشرين اكتسبت الكلمة إيحاءات عنصرية تجعلها أكثر تعقيداً. لذا، يتطلب النجاح في الترجمة الأدبية توازناً بين المهارة اللغوية والفهم العميق للثقافة والسياق، ما يجعلها عملية فنية تتجاوز مجرد نقل الكلمات إلى معانيها الحقيقية.
أما بخصوص العقبة الثانية المتمثلة في تعدد التأويلات، فهي تشكل تحدياً جوهرياً في عملية الترجمة الأدبية؛ فالنص الأدبي بطبيعته متعدد الطبقات والدلالات، يحمل إيحاءات وظلالاً معنوية تتجاوز المعنى المباشر للكلمات؛ فعندما يواجه المترجم نصاً أدبياً، يجد نفسه أمام شبكة معقدة من المعاني المتداخلة، والإحالات الثقافية، والرموز التي ربما تحتمل أكثر من تفسير. هذا التعدد يضعه أمام معضلة حقيقية؛ أي قراءة سيتبنى؟ وأي تأويل سيرجح؟ فالكلمة الواحدة في السياق الأدبي تحمل معاني متعددة قصدها الكاتب جميعاً، إلا أن المترجم ربما يضطر لاختيار معنى واحد في اللغة الهدف. هذه الخيارات الصعبة تجعل من الترجمة الأدبية عملاً إبداعياً يتطلب قدرة استثنائية على التوازن بين متطلبات اللغتين والثقافتين. لذا، أؤمن بأن الترجمة بشكل عام مهارة يمكن تطويرها، بينما الترجمة الأدبية تمثل موهبة خاصة تتطلب حساً إبداعياً ورؤية فنية. وليس كل مترجم، مهما بلغت كفاءته اللغوية، قادراً على أن يكون مترجماً أدبياً متميزاً.
• ما الدور الأساسي للمترجم الأدبي؟ هل هو مجرد نقل للكلمات من لغة إلى أخرى، أم أنه إعادة إبداع للنص الأصلي؟
•• المترجم الأدبي ليس مجرد ناقل للكلمات، بل هو معيد إبداع للنص الأصلي في بيئة لغوية وثقافية جديدة. يقف في منطقة وسطى بين الأمانة للنص الأصلي والإبداع في اللغة الهدف، إذ يسعى لخلق تجربة قراءة موازية لتلك التي يقدمها النص الأصلي. يتحمل المترجم الأدبي مسؤولية استكشاف الطبقات الدلالية المتعددة للنص، وإعادة إنتاجها بطريقة تسمح للقارئ في لغة الهدف بالتفاعل معها بالعمق نفسه. وهذا يتطلب منه اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التأويلات المتعددة، والإشارات الثقافية، والصور البلاغية التي قد لا تجد مقابلاً مباشراً في اللغة المستهدفة. نظراً لهذه التحديات، يعمل المترجم الأدبي كوسيط ثقافي ومفسر ومبدع. قد يضطر أحياناً إلى التصرف في بعض جوانب النص، ليس انتهاكاً للأمانة، بل التزام بأمانة أعمق؛ نقل الجوهر الفني والفكري للعمل الأدبي بكامل تأثيره وجماليته. هكذا يتجاوز دور المترجم الأدبي العملية الميكانيكية لتبديل الكلمات، ليصبح فناً إبداعياً قائماً بذاته، يتطلب موهبةً خاصةً وحساً فنياً مرهفاً، إلى جانب المعرفة العميقة باللغتين وثقافتيهما.
• ما أهمية الحفاظ على «روح» النص الأصلي في الترجمة الأدبية؟ وكيف يمكن للمترجم تحقيق ذلك؟
•• تُعد المحافظة على «روح» النص الأصلي جوهر الترجمة الأدبية الناجحة؛ فالنص الأدبي تجربة جمالية وفكرية متكاملة تحمل بصمة مؤلفها ورؤيته للعالم، وفقدان هذه الروح يحوّله إلى مجرد هيكل لغوي يفتقد تأثيره الخاص. تتجلى أهمية هذا الجانب في احترام خصوصية العمل وهويته الفنية، ونقل التجربة الجمالية بأكملها، وتقديم صورة أمينة عن الثقافة المصدر. لتحقيق ذلك، يحتاج المترجم إلى فهم عميق للسياق الثقافي والتاريخي للنص، وإدراك الأسلوب الشخصي للكاتب ومحاولة محاكاته في اللغة الهدف، مع الموازنة المدروسة بين الترجمة الحرفية والتصرف اللازم للحفاظ على التأثير ذاته. كما يتعين عليه الاحتفاظ بنبرة النص وإيقاعه، واحترام مساحات الصمت والفراغات التي تشكل جزءاً من بنيته، إلى جانب القراءة المتأنية والمتكررة للنص الأصلي لاستيعاب طبقاته الدلالية المختلفة. بهذه الأساليب، يستطيع المترجم تقديم نص لا ينقل المعاني والأفكار فحسب، بل ينقل التجربة الأدبية بكاملها، ما يتيح للقارئ الجديد فرصة التفاعل مع النص كما لو كان يقرأه بلغته الأصلية، محققاً بذلك الهدف الأسمى للترجمة الأدبية.
• ما الأنواع الأدبية الأكثر صعوبة في الترجمة؟ ولماذا؟ على سبيل المثال؛ الشعر، المسرح، النثر الفني.
•• يقف الشعر على رأس الأنواع الأدبية الأكثر استعصاء على الترجمة، إذ يعتمد جوهره على خصائص متأصلة في اللغة نفسها مثل الإيقاع والوزن والقافية والجرس الصوتي. تتفاقم هذه المعضلة في الشعر تحديداً، حيث تتداخل مستويات المعنى مع الإيقاع والصور البلاغية والرمزية. فالشاعر يستثمر خصوصية لغته وتراكيبها وإيقاعاتها، ويلعب على وتر الإيحاءات الثقافية التي قد لا يكون لها مقابل مباشر في اللغة المستهدفة. كثافة اللغة الشعرية وتعدد مستويات المعنى فيها، واعتمادها على الإيحاء أكثر من التصريح، يجعل من المستحيل أحياناً نقل التجربة الشعرية كاملة إلى لغة أخرى. يضاف إلى ذلك أن ارتباط الشعر بأشكال بلاغية وتقاليد شعرية خاصة بكل ثقافة قد لا يكون لها مقابل في الثقافات الأخرى. هنا يقف المترجم الأدبي بين خيارين صعبين؛ إما الحفاظ على المعنى الأصلي مع التضحية بالجماليات الشكلية، أو الحفاظ على الإيقاع والجرس الشعري على حساب بعض ظلال المعنى. فترجمة قصيدة تعتمد على الجناس أو التورية في لغتها الأصلية قد تفقد تأثيرها تماماً عند نقلها حرفياً، بينما قد تؤدي محاولة خلق تأثير موازٍ في اللغة الهدف إلى الابتعاد عن النص الأصلي. تلك المعادلة الصعبة هي ما تجعل ترجمة الشعر تحديداً فناً قائماً بذاته، يتطلب مترجماً يمتلك روح الشاعر وحساسية الناقد وأمانة الباحث، قادراً على الموازنة بين متطلبات النقل الأمين للمعنى وضرورات الإبداع في اللغة المستهدفة. لذلك نجد أن أفضل مترجمي الشعر هم في الغالب شعراء أنفسهم، يمتلكون القدرة على إعادة خلق التجربة الشعرية بدلاً من مجرد نقل كلماتها، محققين بذلك نوعاً من التوازن الدقيق بين الأمانة للنص الأصلي والتأثير الجمالي في اللغة الجديدة.
• ما المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها المترجم الأدبي الناجح؟
•• يتطلب النجاح في مجال الترجمة الأدبية مجموعة متكاملة من المهارات اللغوية والثقافية والإبداعية التي تمكن المترجم من جسر الهوة بين لغتين وثقافتين مختلفتين. أولى هذه المهارات هي الإتقان العميق للغتين المصدر والهدف، بما يتجاوز المعرفة السطحية إلى فهم دقائق اللغة وظلالها ومستوياتها المختلفة، من اللغة الفصحى إلى العامية والمصطلحات المتخصصة والتعبيرات المجازية. تأتي الحساسية الأدبية في مقدمة المهارات الضرورية، إذ يحتاج المترجم إلى ذائقة أدبية مرهفة تمكنه من استشعار جماليات النص وخصائصه الأسلوبية، وإعادة خلقها في اللغة المستهدفة. هذه الحساسية تتطلب قراءة واسعة في مختلف أنواع الأدب، وفهماً عميقاً للتيارات الأدبية والمدارس الفنية. المعرفة الثقافية العميقة بكلتا الثقافتين تشكل ركيزة أساسية أخرى، إذ تمكن المترجم من فهم الإشارات والرموز الثقافية المتضمنة في النص الأصلي، وإيجاد مكافِئات لها في الثقافة المستهدفة. هذه المعرفة تشمل التاريخ والأساطير والتقاليد والأعراف الاجتماعية والمرجعيات الدينية والسياسية. إضافة إلى ذلك، المرونة الإبداعية تمثل مهارة محورية تسمح للمترجم بالتنقل بحرية بين إستراتيجيات الترجمة المختلفة، من الحرفية إلى الحرة، وفق ما يتطلبه النص. هذه المرونة تمكنه من التعامل مع التحديات الخاصة بكل نوع أدبي، سواء كان شعراً أو رواية أو مسرحية. كذلك، تعد القدرة على البحث والتقصي من المهارات التي لا غنى عنها، فالمترجم الأدبي يحتاج باستمرار إلى التحقق من المصطلحات والإشارات التاريخية والثقافية، واستكشاف خلفيات النص وسياقاته المختلفة. هذه المهارة تتطلب صبراً ودقة ومنهجية علمية في التعامل مع المصادر. أخيراً، تأتي مهارات المراجعة والتنقيح الذاتي، التي تمكن المترجم من تقييم عمله بموضوعية وتحسينه باستمرار. هذه المهارة تتطلب قدرة على التفكيرالنقدي وتجاوز التعلق العاطفي بالصياغات الأولية، والانفتاح على ملاحظات الآخرين. تتكامل هذه المهارات لتشكل شخصية المترجم الأدبي الناجح، الذي يقف على الحدود بين ثقافتين، يتنقل بينهما بسلاسة، حاملاً معه كنوز إحداهما إلى الأخرى، محققاً التواصل الحقيقي بين الشعوب عبر الجسر المتين للأدب.
• هل يجب أن يكون المترجم الأدبي مطلعاً على ثقافة ولغة النص الأصلي بشكل عميق؟ وما مدى تأثير ذلك على جودة الترجمة؟
•• نعم، يجب أن يكون المترجم الأدبي مطلعاً على ثقافة ولغة النص الأصلي بشكل عميق، إذ يؤثر ذلك بشكل كبير على جودة الترجمة. الفهم العميق للثقافة يساعد المترجم على التقاط المعاني الضمنية التي قد لا تُترجم حرفياً، ما يعكس الفروق الدقيقة في التعبير الأدبي. على سبيل المثال، بعض العبارات قد تحمل دلالات ثقافية أو تاريخية خاصة، وقد يكون لها تأثير كبير على الفهم الكامل للنص. ويعزز الإلمام بالسياق التاريخي والاجتماعي للنص من دقة تفسير الشخصيات والأحداث، ما يساهم في معالجة النص بشكل أفضل. فالمترجم الذي يفهم الخلفية الثقافية للكاتب يمكنه أن يتعرف على التأثيرات الفكرية والمشاعر التي قد تكون موجودة في النص، ما يمكّنه من نقل هذه العواطف بدقة إلى اللغة المستهدفة. إضافة إلى ذلك، فإن المعرفة العميقة بالثقافة تمنع المترجم من ارتكاب أخطاء تتعلق بالتحسس الثقافي. في بعض الحالات، قد تؤدي الترجمة غير المدروسة إلى استخدام تعبيرات أو مصطلحات قد تكون مسيئة أو غير ملائمة للجمهور المستهدف. على سبيل المثال، قد تكون هناك مصطلحات تحمل دلالات سلبية في ثقافة معينة، لذا فإن الوعي بتلك الأمور يساعد في تجنب الأخطاء التي قد تؤثر على سمعة العمل الأدبي. بالتالي، كلما كان المترجم أكثر دراية بلغة وثقافة النص الأصلي، كانت الترجمة أكثر دقة وعمقاً. هذا الفهم الشامل يعزز التجربة الأدبية للقارئ، إذ يتمكن من استيعاب المعاني الأصلية والتفاصيل الدقيقة التي قد تفوتها الترجمات السطحية. إن الترجمة الأدبية ليست مجرد عملية لغوية، بل هي فن يتطلب حساً إبداعياً وفهماً عميقاً للثقافات المختلفة، ما يجعل من الضروري أن يكون المترجم أكثر من مجرد ناقل للكلمات.
• ما رأيك في الترجمة الحرفية مقابل الترجمة الحرة في السياق الأدبي؟ ومتى يمكن استخدام كل منهما؟
•• تمثل المفاضلة بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة تحدياً جوهرياً يواجه المترجم الأدبي في سعيه لنقل النص من ثقافة إلى أخرى. تنبع هذه الإشكالية من طبيعة الأدب ذاته الذي يتجاوز مجرد نقل المعلومات إلى خلق تجربة جمالية متكاملة، ويعتمد على خصائص متأصلة في اللغة مثل الإيقاع والصور البلاغية والإيحاءات الثقافية والظلال العاطفية. تسعى الترجمة الحرفية في السياق الأدبي إلى التمسك بالنص الأصلي، محافظة على بنيته وصوره واستعاراته وإيقاعه قدر الإمكان. تستمد شرعيتها من الوفاء للرؤية الفنية للكاتب الأصلي وخصوصيته الأسلوبية، وتتيح للقارئ التعرف على عوالم أدبية وأساليب تعبيرية قد تكون غريبة عن تقاليد أدبه المحلي. غير أن هذا النهج قد يؤدي إلى نصوص أدبية تفتقر إلى الانسيابية والتأثير في اللغة المستهدفة، وقد تعجز عن نقل السحر الأدبي والشعري للنص الأصلي، خصوصاً حين تعتمد جماليات العمل الأدبي على خصائص لغوية وثقافية فريدة. في المقابل، تمنح الترجمة الحرة المترجم مساحة للتصرف الإبداعي، فيعيد صياغة النص وفق روح اللغة المستهدفة وأعرافها الأدبية. يركز هذا النهج على نقل التجربة الجمالية والتأثير العاطفي للعمل الأدبي، والبحث عن مكافِئات فنية في اللغة المستهدفة تُحدِث في نفس القارئ أثراً مشابهاً لما يُحدِثه النص الأصلي. تنتج هذه المقاربة نصوصاً أدبية أكثر حيوية وتأثيراً في ثقافتها الجديدة، لكنها قد تبتعد عن روح النص الأصلي وخصوصيته الأسلوبية، أو تحمّله دلالات وظلالاً لم يقصدها مؤلفه.
مع الرموز الأدبية والهياكل الشعرية، يمكن للمترجم أن يتبنى إستراتيجية التوطين (Domestication) التي تميل إلى الترجمة الحرة، بحيث يعيد صياغة الصور الشعرية والإيقاعات والأوزان بما يتناسب مع التقاليد الأدبية في اللغة المستهدفة. فقصيدة إنجليزية ذات إيقاع وقافية محددين قد تتطلب تعديلاً جذرياً لتناسب الذائقة العربية، واستعارة مستمدة من الطبيعة الشمالية قد تحتاج إلى مكافِئ يحمل الدلالة نفسها في السياق العربي. هذا النهج يضمن انسيابية النص وتأثيره الجمالي، ويحافظ على وظيفته كعمل أدبي قادر على إثارة المتعة والتأمل. أما مع الرموز الثقافية والإشارات الحضارية، فيُفضل اتباع منهج التغريب (Foreignization) الذي يميل إلى الترجمة الحرفية، إذ يحافظ المترجم على خصوصية العناصر الثقافية للنص الأصلي. فالعادات والتقاليد والطقوس والمناسبات والأطعمة والأزياء والإشارات التاريخية وهيكلها عناصر تشكل هوية النص الثقافية، ونقلها بأمانة يعزز وظيفة الترجمة كجسر بين الثقافات. فإذا كان هدف الترجمة الأدبية أن تكون جسراً ثقافياً حقيقياً، فلا بد للمترجم أن يراعي هذا التوازن الدقيق بين تقريب العمل الأدبي للقارئ والحفاظ على خصوصيته الثقافية. في نهاية المطاف، تبقى الترجمة الأدبية الناجحة فناً يجمع بين الأمانة والإبداع، تتحرك بمرونة بين الحرفية والحرية، متخذة من كل منهج ما يناسب طبيعة النص وعناصره المختلفة، ومدركة أن غايتها الأسمى ليست مجرد نقل الكلمات من لغة إلى أخرى، بل خلق تجربة أدبية أصيلة تحافظ على روح النص الأصلي وتأثيره، وتفتح أمام القارئ نافذة حقيقية على ثقافة مختلفة.
• كيف يؤثر السياق الثقافي والاجتماعي على عملية الترجمة الأدبية؟
•• يلعب السياق الثقافي والاجتماعي دوراً محورياً في عملية الترجمة الأدبية، متجاوزاً النقل الحرفي للكلمات إلى استيعاب طبقات المعنى العميقة المتضمنة في النص. يواجه المترجم تحدي فك شفرات الرموز والإشارات الثقافية التي تتخلل العمل الأدبي، والتي قد تحمل دلالات بعيدة عن المعاني القاموسية المباشرة. تتجلى أهمية هذا السياق في فهم المرجعيات التاريخية والإشارات الأدبية والأمثال الشعبية التي تعكس روح الثقافة المنتجة للنص. فعبارة بسيطة قد تحمل خلفها تراكماً ثقافياً هائلاً يستدعي من المترجم إلماماً عميقاً بتاريخ الثقافة ومفرداتها الرمزية. كذلك يؤثر السياق الاجتماعي في تشكيل الشخصيات وتفاعلاتها ضمن العمل الأدبي، إذ تلعب الطبقة الاجتماعية والخلفية الاقتصادية والتوجهات السياسية دوراً في رسم ملامح الشخصيات وتحديد سلوكياتها. فهم هذه العوامل يتيح للمترجم نقل الظلال الدقيقة للمعنى ويمنحه القدرة على إعادة إنتاج النص بعمقه ودلالاته. يقي الوعي بالسياق الثقافي المترجم من الوقوع في فخ استخدام تعبيرات قد تحمل دلالات سلبية في الثقافة المستهدفة، أو قد تكون غير ملائمة أو مسيئة. كما قد يتطلب هذا الوعي إجراء تعديلات في الأسلوب أو التركيب اللغوي لجسر الفجوات بين الثقافتين، مع الحفاظ على روح النص الأصلي وجوهره. تتحول الترجمة الأدبية بذلك إلى عملية إبداعية تتطلب مهارة عالية في التنقل بين عالمين ثقافيين، لخلق نص يحافظ على أصالة العمل الأصلي ويتواصل بفعالية مع القارئ في الثقافة المستهدفة.
• ما أهمية المراجعة والتحرير في عملية الترجمة الأدبية؟
•• تشكل المراجعة والتحرير ركيزتين أساسيتين في عملية الترجمة الأدبية، تضمنان ارتقاء النص المترجم إلى مستوى يوازي العمل الأصلي في تأثيره وجماليته. تهدف المراجعة إلى التحقق من دقة نقل المعنى والحفاظ على روح النص الأصلي وأبعاده الدلالية، بينما يركز التحرير على تحسين الأسلوب وصقل اللغة وضمان انسيابية النص وجاذبيته للقارئ. تكمن أهمية المراجعة في كشف الانحرافات عن المعنى الأصلي والتناقضات في المصطلحات والأسلوب، وهي تتطلب قراءة متأنية مقارنة بين النص الأصلي والترجمة. أما التحرير فيتعامل مع النص المترجم كعمل أدبي مستقل، يحتاج إلى صقل وتنقيح ليتوافق مع قواعد اللغة المستهدفة وذائقتها الأدبية. تزداد أهمية هاتين العمليتين في الترجمة الأدبية نظراً لطبيعتها المعقدة وارتباطها بالسياقات الثقافية والتاريخية. فالمراجع يتحقق من سلامة نقل الإشارات الثقافية والتلميحات التاريخية، بينما يسعى المحرر إلى جعل النص متوافقاً مع توقعات القارئ في الثقافة المستهدفة. تمثل المراجعة والتحرير حلقة وصل بين المترجم والقارئ، تضمن وصول العمل الأدبي بأمانة وجمالية تحافظ على قيمته الفنية وتأثيره العاطفي، ما يجعلهما عنصرين لا غنى عنهما في إنتاج ترجمات أدبية ناجحة.
• هل تعتقدين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل المترجم الأدبي في المستقبل؟ ولماذا؟
•• رغم التقدم المذهل في تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرته المتزايدة على معالجة اللغات الطبيعية، أعتقد أن استبدال المترجم الأدبي البشري بالكامل يظل هدفاً بعيد المنال في المستقبل القريب. تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية تقديم مساعدة قيّمة للمترجمين من خلال إنتاج مسودات أولية وفهم بعض التراكيب البلاغية البسيطة، لكنها تفتقر إلى القدرة على فهم الطبقات العميقة للسياق الثقافي والتاريخي التي تشكل العمل الأدبي. الترجمة الأدبية ليست مجرد استبدال كلمات بأخرى، بل هي إعادة إبداع للنص تتطلب فهماً عميقاً للإيحاءات والظلال الثقافية والعاطفية. المترجم البشري يعتمد على خبرته الحياتية وذائقته الأدبية وفهمه العميق للسياقات التي أنتجت النص، ويستثمر تجاربه الشخصية في استكشاف أبعاده العاطفية والنفسية. تبرز محدودية الذكاء الاصطناعي بشكل خاص في ترجمة الشعر الذي يعتمد على تكثيف اللغة وإيحاءاتها وموسيقاها الداخلية، وفي استيعاب المرجعيات الثقافية المعقدة التي تشكل نسيج العمل الأدبي. الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، لا يزال يفتقر إلى الفهم التجريبي العميق للحالة الإنسانية والتجارب البشرية المعقدة التي تشكل جوهر الأدب. مع ذلك، وباعتبار أن الذكاء الاصطناعي منصة تعلم متطورة باستمرار، فمن المحتمل أن تتحسن قدراته في المستقبل البعيد. المستقبل الأكثر ترجيحاً هو نموذج تعاوني، إذ يعمل الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة قوية للمترجم البشري، يوفر له ترجمات أولية وبدائل متعددة، مع بقاء الروح البشرية وتجاربها الحياتية عنصراً حاسماً في الترجمة الأدبية يصعب تقليده بالكامل.
أخبار ذات صلة